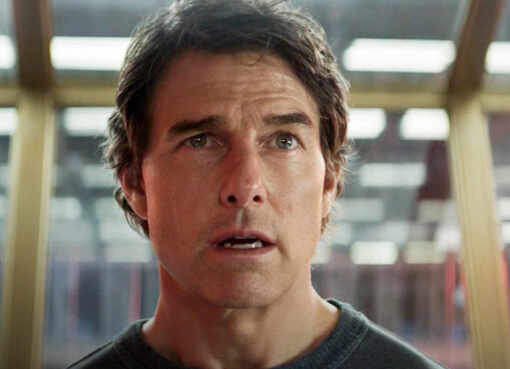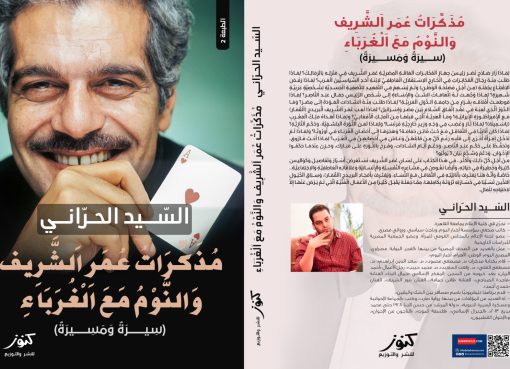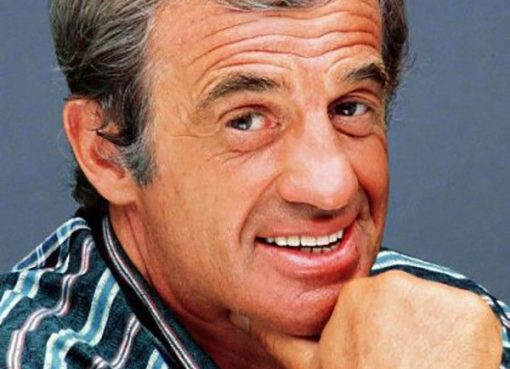استطاع فيلم “الخادمة” (The Housemaid)، من إخراج بول فيغ، أن يفرض نفسه بقوة وسط زخم الإنتاجات السينمائية التي نافست خلال موسم عطلات نهاية عام 2025، محققًا إقبالًا جماهيريًا لافتًا، واحتلالًا بارزًا في التغطيات الإعلامية الأميركية، سواء من حيث نجاحه التجاري أو من خلال مقاربته النقدية للفوارق الطبقية وصراعات الأدوار الجندرية داخل العائلة الأميركية المعاصرة.
ويعتمد الفيلم على رواية فريدا مكفادين التي حملت الاسم ذاته، وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا عام 2022، فيما تولت ريبيكا سوننشاين كتابة السيناريو، وجمعت البطولة بين سيدني سويني وأماندا سيفريد. وبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأميركية يوم 19 دجنبر 2025، ليقود نجاحه السريع إلى الإعلان عن إنتاج جزء ثانٍ.
تتمحور القصة حول ميلي كالواين، شابة مثقلة بماضٍ مضطرب وسوء حظ متراكم، تحاول إعادة بناء حياتها والالتزام بشروط الإفراج المشروط المفروضة عليها. وفي سبيل البحث عن بداية جديدة، تقبل وظيفة مدبرة منزل مقيمة لدى زوجين ثريين يعيشان في ضواحي لونغ آيلاند، هما نينا وينشستر وزوجها أندرو، حيث تنتقل للإقامة داخل قصر فخم يبدو في ظاهره تجسيدًا للاستقرار والأمان.
غير أن هذا الانبهار الأولي لا يلبث أن يتلاشى، إذ تنكشف تدريجيًا شبكة من الأسرار والألاعيب النفسية التي تحيط بالمكان وساكنيه، ويتحول بريق الثراء إلى واجهة تخفي خلفها عالما قاتمًا من التوتر والتهديد وانعدام اليقين. ويغلف المخرج شخصياته بأجواء مشحونة بالغموض والقلق، مستلهمًا تقاليد السينما القوطية التي تقوم على العزلة والأسرار العائلية والشخصيات المضطربة، مع توظيف الإضاءة الخافتة والظلال العميقة لإنتاج شعور دائم بالارتياب.
ويمزج فيغ بين الكوميديا السوداء وعناصر الرعب النفسي في سرد يتأرجح بين مشاهد بصرية لافتة وأخرى أقل تأثيرًا، مقدمًا العمل بوصفه تعليقًا ساخرًا على عام اتسم بتصاعد الجدل حول التفاوت الطبقي. ويقوض الفيلم فكرة أن البيت والأسرة والثراء المادي تمثل بالضرورة معادلًا للأمان، كاشفًا أن هذه المظاهر قد تخفي خللًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا.
ويتجلى ذلك بوضوح في المشهد الافتتاحي الصادم، حين تكتشف ميلي أن غرفتها ليست جزءًا من المنزل الفاخر، بل مساحة ضيقة في الطابق العلوي بلا نوافذ حقيقية، تضم سريرًا معدنيًا ومروحة صاخبة. ويُقدَّم هذا الاكتشاف في صمت تام، دون موسيقى أو مؤثرات، لتتكشف المفارقة بحدة: بيت مثالي في الخارج، وغرفة أقرب إلى زنزانة في الداخل.
وتتسلل هذه المفارقة إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث يتنامى الإحساس بانعدام الأمان داخل فضاء يفترض أنه ملاذ. ويتجسد ذلك في التقلب السلوكي الحاد لسيدة المنزل، التي تنتقل من الود إلى القسوة دون مبررات واضحة، محولة العلاقة إلى لعبة نفسية قوامها الارتباك الدائم. ويخلق هذا التناقض، في مواقف اعتيادية مثل تحضير الطعام أو ترتيب المنزل، شكلًا من الكوميديا السوداء القاتمة، حيث يُفرض العنف النفسي خلف واجهة من الابتسامات واللياقة الزائفة.
وتبلغ السخرية ذروتها في مشاهد العشاء والضيوف، حين تُستعرض قيم الاستقرار العائلي والنجاح الطبقي، بينما يُمارس الإقصاء والإذلال بصمت داخل الكادر نفسه، عبر لغة الجسد والنظرات. ويعزز المخرج هذا الإحساس بتوظيف ثيمات المراقبة والأبواب المغلقة والأصوات غير المرئية، ليحول البيت، برمزيته التقليدية، إلى فضاء للشك والهشاشة.
ولا ينبع الخطر في الفيلم من حدث مفاجئ، بل من تطبيع الإذلال والغموض، حيث يصبح الإخضاع جزءًا من الروتين اليومي، وتتحول السخرية إلى بنية نفسية تكشف هشاشة السلطة والعلاقات داخل البيت الأميركي. وفي هذا السياق، يمزج بول فيغ الميلودراما بالتشويق والمبالغة والسخرية، مستحضرًا تقاليد سينمائية كلاسيكية، لكنه يفرض على المشاهد حالة وجدانية متوترة تتأرجح بين الضحك والقلق.
وتنجح سيدني سويني في موازنة هذا الحضور الإخراجي الطاغي، مقدمة أداءً يمنح الشخصية عمقًا إنسانيًا، بينما تضفي أماندا سيفريد حيوية خاصة على شخصية نينا، مجسدة القلق والتناقض الداخلي ببراعة. ويعزز التصوير السينمائي هذا التوتر عبر تباين بصري محكم، حيث تهيمن الإضاءة المنظمة والتأطير النظيف في البداية، قبل أن تتسلل الظلال تدريجيًا وتضيق الكادرات مع تصاعد الأحداث، في انعكاس بصري لحالة الاختناق النفسي.
ويعتمد المونتاج إيقاعًا هادئًا ومتدرجًا يسمح بتراكم القلق بدل تفجيره، مستحضرًا روح أفلام الإثارة المنزلية في تسعينيات القرن الماضي، ولكن بلمسة معاصرة تركز على الحالة المزاجية وعدم الاستقرار أكثر من الصدمة البصرية المباشرة.
سينفيليا