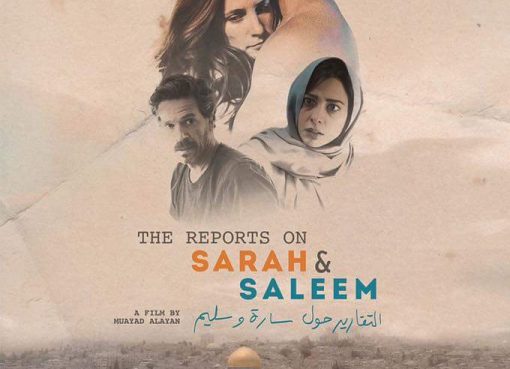يصنف فيلم يوم الدين للمخرج المصري أبو بكر شوقي ضمن الأفلام الروائية التوثيقية، التي ترصد صراع الوجود والكينونة لأقلية مضطهدة ومقهورة تعاني ويلات البؤس والحرمان، في مجتمع تتناقض اطيافه وطبقاته وقيمه. وتكمن لمسة الابتكار والتجديد في هذا الفيلم من خلال تسليط المخرج الضوء على قضية اجتماعية لم يسبق التطرق إليها في السينما المصرية، ألا وهي قضية مرضى الجذام أو مستعمرة الجذام الموجودة في منطقة ابو زعبل بالمنيا جنوب مصر.
وطالما أن الموضوع واقعي يستثمر قضية اجتماعية تعيشها أقلية مصابة بهذا المرض الجلدي، فقد اختار شوقي انتقاء أبطال فيلمه من الأشخاص الواقعيين الذين عاشوا هذا المرض وعانوا من نظرة المجتمع الدونية لهذه الفئة. فكان اختيار راضي جمال الذي عولج مؤخرا من هذا المرض، ليجسد طبقته فنيا وإبداعيا من خلال السينما، فتم تدريبه لمدة أربعة أشهر حتى يستأنس مع دوره البطولي ومع عدسة الكاميرا التي تلقي الضوء على مآسي هذه الفئة. كما اختار المخرج دور البطولة الثاني لممثل هاو آخر وهو أحمد عبد الحافظ الذي لعب دور الطفل الأسود أوباما، والذي يعاني هو الآخر من تمييز المجتمع ونظرته الدونية.
لهذا فاختيار ممثلين واقعيين عاشوا التجربة وراكموا المعرفة، كان هدف المخرج ابو بكر شوقي في هذا الفيلم، حتى يعطي لأحداثة طابعا من الواقعية التي استثمرت قصة حقيقية ومسارا توثيقيا يعالج معاناة المرض، ومعاناة النظرة للمرض.
إذا تأملنا عنوان الفيلم “يوم الدين”، سنجد أنه يحيل إلى زمن مستقبلي مرتبط بأمور روحانية غيبية لها علاقة وثيقة بالحقل الديني، فيوم الدين المقصود هنا هو يوم الآخرة أو يوم القيامة، أو اليوم الموعود في حياة ما بعد الموت، والذي يتصف بالخلود والاستمرارية والدوام. إذا فما علاقة هذا العنوان ذو الإيحاء الديني بقضية مرتبطة بالمرضى والمعتلين ؟
بالنظر إلى مضمون الفيلم وأحداثه يتبين أن الآخرة أو يوم الدين هو الحلم والأمل بالنسبة لأبطاله وشخوصه، وهذا المبتغى يتسم بخاصيته التعويضية المنفسة للكرب، والمضمرة للشقاء، والمستبدلة للمعاناة والقهر….إن يوم الدين هنا هو تعويض نفسي اختار الأبطال طريق الإيمان به والتطلع إليه، بسبب الإخفاق في الحياة. والإخفاق هنا لا نقصد به الفشل الشخصي المقترن بالعمل والوظيفة والفاعلية، بل نعني به الإخفاق القهري الذي فرضه المجتمع ونظرته ومؤسساته وطبقاته….وبالتالي فالمعنى المضمر هنا يحيل إلى حياة التهميش والنفي والاحتقار والحرمان التي تعيشها فئة مقصية اجتماعيا في مواجهتها لغول المجتمع وأشراره المادية، الطبقية، التهميشية. ولمواجهة هذا الغول تتشبت هذه الفئة المقصية بسلاح الحياة والمقاومة والأمل والتطلع إلى المستقبل، وتجد في مساواة الآخرة، وعدل يوم الدين، علاجا لكل همومها وأحزانها، وتعويضا عن حياة الغدر والظلم التي تعيشها في الدنيا.
وقد تطرق مضمون الفيلم لقضية هؤلاء المهمشين، مترصدا مسار البطل بشاي وصديقه أوباما المعلنان عن تمردهما على هذا الواقع ورفضهما لكل أنواع التمييز بين البشر. فالفيلم يحكي عن رجل قبطي ” بشاي”، شفي من مرض الجذام، لكن آثاره وبثوره ظلت بادية للعيان. يحاول بشاي مواجهة عقبات الحياة في مستعمرة الجذام جنوب مصر، بعد أن تخلى عليه الجميع: الأهل والأسرة والأصدقاء…. فيبدأ بالعمل جامعا للقمامة ومسترزقا ببعض ما يجد من مواد صالحة فيها. يتعرف على طفل صغير يدعى أوباما، ثم تمرض زوجته المجنونة وتموت بعد ذلك تاركة بشاي وحيدا يتحدى قمامة الحياة.
لكن هذا الحدث سيكون له وقع التغيير والتحول في حياة بشاي، فزيارة أم الزوجة للترحم على قبر ابنتها، ترك في نفسية البطل أثرا عميقا ورغبة دفينة في تدبير الأمور والبحث عن الجذور وإعلان الحضور وترك القبور. ليقرر بعد ذلك البحث عن الأصل والسؤال عن الأهل، مرفوقا بالطفل أوباما الذي أصر على مشاركة بشاي رحلة الحياة وإثبات الذات.
جهز بشاي حماره وعربته الصغيرة، مقررا بدأ المسار ومواجهة القفار وتحمل الأشرار. لينطلق في رحلته المبهمة المعالم والهلامية المنحى إلى المدينة، حيث الأب والأخ والحنان الذي فقده منذ طفولته الصغيرة. يواجه بشاي في رحلته كل أنواع الصعوبات والتحديات والعراقيل، يصابر على تجاوزها والمرور من محنها بمساندة الرفيق الوفي اوباما. تطول الطريق وتضيع علاماتها، تتعطل عربته، يضيق الجو الخانق بالحر، تمتد فسحة القفر والخلاء والصحراء، يموت الحمار المعين….ورغم ذلك يجاهد الصديقان للوصول إلى مبتغاهما وإعلان وجودهما الإنساني. يصل بشاي وصديقه صعيد مصر، يلج إلى عالم الحياة مقبلا مدبرا متحمسا كطفل صغير. يتشبت بخيط الأمل والحلم في لقاء أبيه وأسرته، لكنه يصدم بواقع مر، حالك، قوامه الظلم والسخرية والاحتقار والتعدي على الحقوق.
يعاني الأمرين من نظرة المجتمع الاحتقارية لحاله (الجذام) وحال صديقه (لونه الأسود)، تتعقد ظروفه وحالته من كثرة الظلم والاستهزاء الذي يلاقيه من مجتمع فقد قيم الرحمة والإيخاء والمساواة، ولا يجد سبيل السعادة إلا رفقة شحاذين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا يحن لحال إلا حال مثلها تشابهها. يرغب في الوصول إلى أهله، يسائل الجميع عن بلدته، يقابل في كثير من الأحيان بالقمع والتنمر والظلم، لكنه يجابه ويصارع ويكابد من أجل الحياة والحق في السعادة والوجود والانتماء. يعيش حياة التشرد، يبييت في العراء والخلاء أحيانا، يحتمي بالمسجد ودور العبادة أحيانا أخرى، يجلس فوق الحشائش والرصيف أوقاتا أخرى…المهم أنه يقاوم ولا يعبأ بضغوط الاستسلام والانهزام.
لا المضايقات ولا المطبات التي واجهت بشاي وأوباما، منعتهما من الوصول إلى مبتغاهما. تمكنا أخيرا من البلوغ إلى المكان المعلوم، إلى الحلم المسلوب، إلى الأصل المنزوع. وبمساعدة أصدقائهم الشحاذين، سيصل البطلان إلى منزل الأسرة المفقودة، إلى بيت الأخ المتزوج والأب القابع في كرسي الشلل، وكأن القدر يحول الوجهة ويعكس الآية. فمن تخلى في الماضي عن ابنه، صاحب العاهة المستديمة، يجد نفسه ـ مع مرور الزمن ـ في حال أمر من الحالة التي تهرب منها. لكن المختلف والمغاير هنا هو أن الإبن لم يبادل الأب نفس الموقف، ولم يكرر نفس الخطأ، ليقرر ربط صلة الرحم بالأب ومد خيط الوصال واللقاء بالأخ والأسرة. ليكتشف، في النهاية، أن موقف الأب بالتخلي عنه جاء جبرا لا اختيارا. فالأب كان يرغب في الحياة السعيدة لإبنه، وهذه الحياة ما كان بشاي ليتذوق طعمها لو أنه بقي في المدينة وانصهر مع طابعها المادي والوحشي. فحياة الاستغلال والظلم والاحتقار هي عنوانها ومضمونها، لذا اختار الأب الطريق الأصعب بالنسبة له، لكنه الأسعد بالنسبة لابنه الذي انتقل إلى مستعمرة البؤساء والمهمشين، ليعيش حياة البهجة والهناء والاستقرار.
يقرر، أخيرا، بشاي ورفيقه أوباما العودة مجددا إلى المستعمرة، حيث الداء والدواء، حيث العاهة والسعادة، حيث روح المساواة والرحمة، حيث الأناس الأخيار والطيبون، حيث أحاسيس البهجة والسرور، تنسل من قلب المكان رغم وضعه ووضاعته، ورغم بساطته ورداءته. هناك وجد بشاي ضالته وأمنه وراحته النفسية. هناك كان منطلق الرحلة وإلى هناك سيصل المسار : مسار الحياة والحلم والسعادة.
إذا فالفيلم هو صرخة روحية، وبوح للرغبة، وإعلان للحياة من طرفة فئة مهمشة تعيش الحرمان والاحتقار من جميع النواحي. وقد حاول المخرج تعقب مسار هذه النظرة الدونية من خلال التقاط مشاهد تصور بؤس الواقع المنسي: واقع الظلم والاحتقار والعنصرية، واقع القمامة والمستنقعات والأمراض والتشرد. ويمكن استجلاء معالم هذا الواقع، وخصائصه من خلال المشاهد التالية :
ـ المشهد الذي صور لنا المرأة التي تسقي الماء من نهر النيل، وهي تنعت بشاي بصفات قدحية، بسب استحمامه، وهو المريض بالجذام، في مياه صالحة للشرب. فالاستحمام هنا جاء مرفوقا بطقس للرقص والاستجمام، وهذا رمز سينمائي يوحي بالتطهر والصفاء، يرمز للبهجة والفرحة، يرصد البطلين (المريض بالجذام، والطفل المتشرد) وهما يعلنان الحياة وتحدي الصعاب، إنها صرخة المنسيين والمهمشين ضد نظرة المجتمع الاحتقارية.
ـ كذلك النظرة الازدرائية للمجتمع، تظهر في المشهد الذي يصور بشاي وهو في السجن رفقة سجين آخر. هذا الأخير سيهرب بمجرد مشاهدته لوجه بشاي، خوفا من صورة ملامحه المليئة بالجراد والحشرات حسب نعت هذا السجين. وهو نعت قدحي، يفتقد لقيم الرحمة والعطف والاحترام، في مجتمع تلطخت أخلاقه، وتلوثت مشاعره، وتحجرت أحاسيسه.
ولمقاومة هذا الوضع وهذه اللحظة المتأزمة، سيقرر بشاي الانتقال إلى المدينة بحثا عن أبويه وأسرته وجذوره. وإذا كان بطلنا قد عاش في المستعمرة حياة السعادة والهناء رفقة الفتى أوباما وباقي السكان الطيبين، المتواضعين، البسطاء، فإن انتقاله للمدينة شكل جسرا للتحول إلى حياة البؤس والاستغلال من طرف قوى الظلم والشر: الطبيبة – الشرطة – اللصوص- مراقب القطار ـ السكان…. وذلك بطرق متعددة، إما عن طريق السخرية والاستهزاء، أو الاستخفاف والإذلال، أو الاعتداء والسرقة، أو الاتهام والسجن ..
وفي رحلتهما اعتلى بشاي عربته التي يجرها الحمار، وبرفقته الفتى الأسمر أوباما. تواجههما الصحراء المقفرة، بحرارتها المرتفعة وقساوة العيش فيها. وما اختيار المخرج لفضاء الصحراء إلا تدليل رمزي عن هول المصاعب والصدمات التي تهدد مصير الأبطال في الرحلة. رحلة البوح بالوجود والإعلام بالأنا، في واقع غير متكافئ لا يعترف بقدرات المرضى والمعطوبين وذوي العاهات. لكن الحمار والعربة في الفيلم لهما دلالة تقابلية مع هذا الواقع الظالم والمجتمع المظلم. فكلاهما وسيلتان للعبور والوصول، وكلاهما دليلان يبرزان صمود البطلان، وقوة تحملهما وعزيمتهما في مواجهة صحاري الظلم والإذلال. ورحلتهما هي إفصاح عن الرغبة، وبوح بالأمنية وإفشاء للحلم. حلم الانطلاق والحرية في التعبيرعن الذات المهانة، بينما الحمار والعربة دليل على قوة العزيمة والتحدي التي ميزت بشاي وأوباما الراغبان في تحدي هذا الواقع المتأزم. ورغم العراقيل ولحظات الكرب والهم والغم التي واجهتهم، والتي رمز لها المخرج بلقطة انكسار عجلات العربة إيحاء بتوالي المصائب التي حاولت تكسير همتهم. إلا أن نداء أوباما من بعيد لصديقه بشاي، وهو قادم من امتداد شاسع في الخلاء والتراب، هو إشهار لعودة الحلم، والأمل، والطموح، والهمة، في صراع الأقدار المعيقة لمحاولة الذات استنشاق نسماتها من الحياة. والسكة الحديدية التي رصدتها عدسة الكاميرا في هذه الصحراء هي حجة أخرى على العسر والعقبات التي تواجه الأبطال. ومرورهم فوق هذه السكة، هو نجاح للتجربة، وفلاح في الدفاع عن كرامتهم، والمنافحة عن حقهم في عيش ما يعيشه الآخرون .
تعرض بشاي لكل أنواع السخرية والمضايقة من طرف سكان المكان الجديد الذي زاره (الصعيد). تحمل الاستهزاء والاعتداء والحط من القيمة، سواء بسبب شكل وجهه المخيف أو بسبب ديانته المسيحية القبطية. ومن شدة الاحتقار غطى بشاي وجهه بشبكة بيضاء شفافة، حتى يتفادى نظر الناس وانزعاجهم وتهكمهم. ورغم ذلك استمرت حلقة التمييز والاضطهاد والظلم، لينفجر بشاي في مشهد مثير مصرحا بجملة لها إيحاء بليغ : ” ايه يا عم أنا مش بني آدم ولا ايه”. عبارة تلفظ بها بشاي بعد أن وصل السيل الزبى من كثرة الاحتقار والتنمر الذي كان يتعرض له بسبب شكله ومرضه ووضعه المادي، خاصة حينما هاجمه مراقب التذاكر في القطار بسبب عدم دفعه لثمن التذكرة (الفقر والحاجة).
لم يجد بشاي الحنان إلا في نوعية مخصوصة من الناس، هم أولئك الذين يشاركوه الوضع، أو يماثلوه الشكل، أو يشابهوه في الطبع. فالنوع الأول (الوضع الاجتماعي) مثله الولد الأسمر أوباما والحمارالأبيض “حربي” ….وكلاهما مهمشان محتقران من طرف المجتمع سواء الطفل الأسود أو الحمار، الحيوان، ذو السمعة المنحطة. ورغم ذلك تعمد المخرج اختيار اللون الأبيض للحمار، تلميحا لما يتصف به هؤلاء البسطاء من روح نقية و أخلاق صافية وقلب طاهر….فرغم القهر والغم، إلا أنهم تشبتوا ببريق الأمل، والرغبة في الحياة التي تفيض من أحاسيسهم.
النوع الثاني، هم أولئك الذين يماثلوهم في الشكل وأقصد هنا طبقة الشحاذين المعاقين الذين ينتمون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. وهؤلاء صادفهم الأبطال في شوارع الصعيد الموحشة والمتأزمة، وأغلبهم يعاني من عاهة مستديمة (قطع الأرجل – قطع اليدين – العمى – الصم والبكم….) . إنها فئة المهمشين المنسيين من وعي المجتمع وذاكرة المسؤولين، يعيشون في الضواحي والعراء والخلاء، يضطرون للتسول وطلب الحاجة من أجل سد لقمة العيش، لكن رغم ذلك مشاعرهم لطيفة وأرواحهم رحيمة وصدورهم مشفقة. وقد كان لهم الدور البارز في مساعدة بشاي وصديقه للوصول إلى مكان الأسرة، بعد أن استقبلوهم وأطعموهم وآووهم في مقرهم البسيط.
النوع الثالث، وهي الفئة التي تشابههم في الطبع، وهنا نقصد الخلق الحسن والطيبة والبساطة والرحمة والبراءة. وهؤلاء هم الأطفال الصغار الذين شاركهم أوباما لعب الكرة بمرح وبهجة واستمتاع في الصعيد، بالإضافة إلى سكان المستعمرة الذين لم يبخلوا بالود والمساعدة والحنان على بشاي، عكس أهل المدينة، أصحاب القلوب المتحجرة والموصدة في وجه هؤلاء الأبرياء.
الفيلم إذن، هو صرخة من صرخات المهمشين والضائعين والتائهين في عالم بلا رحمة، وكون بلا رأفة، ومجتمع بلا رقة. وثنايا هذه الفئة المهمشة متعددة في الفيلم، وظاهرة في أشكال متنوعة أبرزها:
ـ بشاي، صورة المقهورين من مرضى الجذام، والذين طردوا من عطف المجتمع إلى عالمهم الخاص (مستعمرة الجذام).
ـ الطفل أوباما، صورة الأطفال المتشردين الذين فقدوا الصلة بالأسرة والمجتمع بسبب وضعيتهم البئيسة، وهيئتهم الجسدية المحتقرة (سواد البشرة)، وأصلهم المرفوض (المهاجرون السود القادمون من السودان).
ـ زوجة بشاي المجنونة : صورة الشخصيات التي حطمتها هموم الحياة وهضمها الزمن، فانزوى عقلها بعيدا، والتهمها المرض التهاما، لتخر قواها بعد ذلك وتموت في المستشفى الخاص بمستعمرة المنسيين. سندها الوحيد هو زوجها بشاي العطوف على حالتها والمشارك لإحساسها بالمعاناة. أما أمها فتركتها تصارع القدر، وسلمتها لوحوش البشر، ولم تستحضر ذكراها إلا وهي في غياهب القبر (زيارتها لقبر ابنتها).
ـ المتسولون والشحاذون : وكلهم من فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حطمهم الدهر بكلومه وآلامه، هجرهم الرفيق الأنيس، والأخ الرحيم، في أحلك الظروف وأصعب اللحظات. فوجدوا أنفسهم في مستنقع الفاقة، وظلمات الحاجة، ليتوه بهم الزمن، وتدهسهم عجلات الواقع، وتعصف بهم رياح المآسي. فكان ردهم في الفيلم، بهذا التعبير البليغ: “احنا ضحايا أشكال تايهة ….احنا منبوذين….احنا عايشين على أمل إن يوم الدين كلنا سواسية”. وهي جملة فسيحة المعاني، شاسعة الدلالات، تحيل إلى وضعية هذه الطبقة المهمشة والمحتقرة والمحطمة، والتي تعيش على أمل الخلود والراحة والصفاء في يوم الدين. فأحلامهم التي يستنشقون نسيمها، ويعوضون بها همهم وضعفهم، هي الأمل في مساواة غيبية ستتحقق آجلا، في يوم البعث والخلود (يوم الدين). إنها الرغبة المكبوثة في تحقيق حلم المساواة والعدل، الغائب عن واقع الظلم والآثام والاستغلال.
ينتهي الفيلم بمشهد اللقاء الحميمي بين بشاي وأسرته (الأخ والأب). يلاقي أباه، الذي أصابه الشلل، وهو جالس على كرسيه لا يتحرك. والحوار الأخير بينهما يحمل رمزية ودلالة مركزية في الفيلم. فالأب لم يترك ابنه في مستعمرة الجذام حتى يتخلص منه، ومن شكله، ومن مشاكله. بل مضطرا لا مختارا، حتى يخلص ابنه من ويلات المجتمع واضطهاده واحتقاره، وحتى يخلق عالما سعيدا لابنه يحس فيه بالبهجة والمساواة والكينونة. عالم تنمحي فيه التفيئة، وتغيب فيه الفوارق، وتعم البساطة والتواضع في كل أرجائه، وهذا ما وجده في المستعمرة. يقرر بشاي بعد ذلك العودة إلى أصله، إلى مستعمرته، إلى بلدته التي حن إليها وإلى أحبابه فيها. رفاقه الذين شاركوه الحلو والمر، دون تمييز أو سخرية أو إذلال. هناك سيحس بشاي بطعم الحياة، وهناك سيؤسس عوالم رغباته وأمنياته، وهناك سيبني يوم دينه الذي حلم به.
على المستوى الفني تنوعت اللقطات الفيلمية في هذا العمل السينمائي، بين لقطات بعيدة ولقطات مقربة ولقطات متوسطة. فاللقطات البعيدة استهدفت اقتناص الهامش المنسي من مستعمرة الجذام، من خلال التركيز على جغرافيتها البئيسة، وحالتها المزرية : التلوث – المزبلة – التشرد – العشوائية….أما اللقطات المتوسطة فقد أحاطت بمغامرة الأبطال ورحلتهم الصعبة إلى الصعيد من أجل تحدي الواقع وإعلان الوجود. بينما جاءت اللقطات المكبرة في مشاهد ضئيلة، لأن المخرج تجنب تصوير ملامح بشاي الجذامية إثباتا لدوره وقيمته في المجتمع المساوية لجميع الفئات الإنسانية. إنها نظرة فنية توحي بنقل واقع المسحوقين بصورة صادقة كونهم أفرادا لا يختلفون عن باقي الناس. واللقطات المكبرة، القليلة، التي حضرت هي لرصد ملامح الأسى والمعاناة والحزن التي انجلت على محيا بشاي في الفترات الحرجة والأوقات الحالكة التي مر منها.
ومن الملاحظات الفنية التي برزت في الفيلم، الإكثار من اللقطات الخلفية التي أطرت الشخصيات من الخلف. فقد تعددت المشاهد التي آثر فيها المخرج قبض أبطاله من الخلف، والهدف فني جمالي بطبيعة الحال، لا مجرد اختيار عشوائي واعتباطي. فالتقاط الشخصيات من الخلف هو نفي للأنا والكينونة بالنسبة لهم، وهو انتقاء إبداعي ابتغى التدليل على الوضعية الدونية لأبطال الفيلم، في مجتمع هضم حقوقهم وكرامتهم هضما تاما. إن التصوير الخلفي هو رصد هامشي من العدسة، وهو إضاءة مركزة لطبقة تقوقعت في الأسفل، طبقة حطمها المجتمع، وكسر عزيمتها الواقع. لهذا أراد المخرج التلميح والتنبيه لهؤلاء الذين نسيهم الزمن، وابتلعتهم الحياة، بلقطات ركزت عليهم جانبيا، حتى يتسنى للمشاهد فهم الرسالة، واستيعاب المقصد.
فيما يخص الإنارة اختار المخرج، تقسيم أدوارها إلى وجهين متناقضين : وجه ساطع وقوي في بداية الفيلم ولحظاته الأولى، وبالضبط حينما كانت عدسة الكاميرا تتجول في مستعمرة الجذام مركزة على حياة المهمشين في هذا الموقع. والمغزى من هذا الاختيار هو توجيه الضوء على هذه الطبقة المحتقرة الشكل، والصافية القلب. طبقة بالرغم من مآسيها وجروحها، إلا أن الطهارة والنقاء والابتسامة هي عنوانها في الأخلاق والسلوك والفعل. لهذا اختار مبدعنا السينمائي أبو بكر شوقي تعزيز الإضاءة الكاشفة لمسار الأبطال في هذه المستعمرة. فرغم رداءتها وعشوائيتها وبؤس ساكنيها، إلا أن بساطة هؤلاء، وصفاء سريرتهم، فرض على المخرج هذا الأسلوب السينمائي، إيمانا منه بقيمتهم ودورهم الكبير في خلق البهجة والسرور وروح الإنسانية لدى الجميع.
أما في الجزء الثاني من الفيلم، وأقصد هنا رحلة الأبطال إلى الصعيد (المدينة)، فالإنارة تدرجت في التراجع والخفوت من مرحلة لأخرى. وكلما تعقدت الأحداث وتأزمت اللحظات إلا وضعفت الإنارة وساد الظلام والليل، خاصة في المدينة، حيث طغيان قيم الشر والرذيلة، وحيث سيادة قانون الغاب، وهيمنة الطابع المادي الاستغلالي. هذا الوضع السلبي يضع الإنسان الضعيف أو صاحب الحاجة في قفص الظلم، والاحتقار، والاستبداد، من طرف القوى الكبرى التي تتخذ من السلطوية والتنمر شعارا لها في مواجهة المستضعفين. لذا يمكن القول أن الإنارة الساكنة والمنخفضة الشعاع، هي ترميز لحالة اللاتوازن التي يعيشها مجتمع المدينة، وإيحاء بعدم الاستقرار في الفكر، والخلق، والروح، والقيم السائدة بين الأفراد هناك.
والمخرج ركب لمحة فنية من “جماليات القبح” بمشاهد كوميدية سوداء، تزيد بعضا من السعادة القاتمة على الظلام الذي تصوره عدسات الفيلم. بشاي الذي اختار أن يقوم برحلة للبحث عن عائلته في الصعيد، فقرر أن يترك “المستعمرة” لينتقل إلى عالم المدينة ويجد أهله، وفي مساره الحالك واجه كل العقبات : اللصوص، التشرد، السجن، الفقر، الإذلال، والتمييز….
وعلى مستوى التمثيل، يعد هذا العمل من أبرز ما قدم في هذا الصدد المحاكي لأدوار وقصص واقعية، كون المخرج غلب الطابع الإنساني الصادق والحقيقي، على التشخيص المفتعل والمحاكي أو المقلد، وذلك راجع بالأساس لانتقاء أبطال الفيلم من الأشخاص الواقعيين (ممثلين هواة) الذين عاشوا القصة، وراكموا التجربة. لا الممثلين المحترفين الذين يفتقدون الصلة والمعرفة بعالم المستعمرة.
وفيما يخص موسيقى الفيلم التصويرية، فقد أنجزها الفنان عمر فاضل، وجاءت صامتة، نغماتها صادرة من عمق الأحاسيس، تحادي الوجود، وتتسق مع الروح، وتقارب التجربة الإنسانية. منسجمة مع قوة الإحساس بالمكان والزمان، معبرة عن التناقض الواضح في مجتمع الاضطهاد ورفض المنبوذين، مجتمع يدعي الفضيلة خلقا ودينا، ويناقض ادعاءه في السلوك والعمل. وقد اتخذت الموسيقى وثيرة رتيبة وهادئة في مشاهد الرحلة والمآسي التي رافقتها، بينما زاد إيقاعها دينامية في لحظات الفرح وإعلان الحياة.
وقد جاء المكان متناقضا ومتعاكسا في الفيلم، كونه يلمح إلى عالمين لا تربطهما أي صلة تشابه أو تقارب : عالم المستعمرة وعالم المدينة (الصعيد). فمستعمرة الجذام ظاهريا هي مكان موحش، وهامشي، تملأه الأوساخ والقمامة، ويعمه المرض والوباء، ويسوده التشرد والفاقة. ورغم هذه الأوصاف إلا أن المخرج صور هذا المجال بلقطات ناصعة، ومشرقة، تماشيا مع إشراق الأحاسيس وصفاء الخلق وبياض القلوب الذي يميز أهل هذه المستعمرة. وعكس ذلك نجد، في المقابل، عالم المدينة بضجيجه، وكثافة سكانه، وتجهيزاته، ومعالمه، ووسائله المتعددة في الرفاهية والحياة. وقد جاء هذا الفضاء معتما في الفيلم، قاتما، ضبابيا، مشوشا، نظرا لكونه حيزا شاذا عرف كل أنواع القمع والازدراء والمهانة.
يبقى أن نشير، في الختام، إلى أن فيلم “يوم الدين” يعد من أبرز الأفلام العربية والعالمية التي أنتجت السنة الماضية (2018)، والدليل على ذلك هو ترشيحه للسعفة الذهبية بمهرجان كان الفرنسي، وفوزه بجائزة Francois chalais في المهرجان نفسه، ثم ترشيحه في القوائم الأولية لجوائز الأوسكار. كما فاز بالعديد من الجوائز السينمائية العربية، كجائزة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي، وجائزة التانيت الفضي لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان قرطاج السينمائي. وقد لقي هذا العمل الفني استحسانا كبيرا وإطراء واسعا من طرف الكثير من النقاد، لكونه واحدا من أبرز الإنتاجات السينمائية العربية التي أنتجت في الآونة الأخيرة.
محمد فاتي