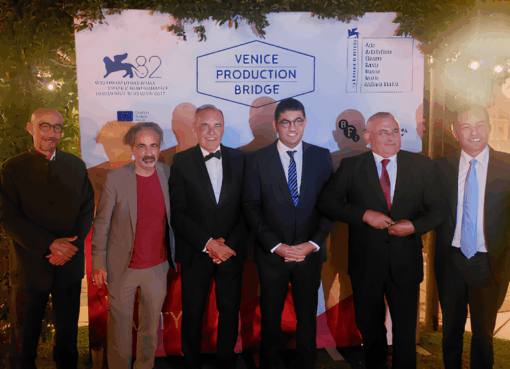مهرجان مراكش الدولي للفيلم .. نجوم وتساؤلات
-محمد اشويكة-
اختتم مهرجان مراكش الدولي للفيلم فعاليات دورته الثالثة عشرة التي امتدَّت من 29 كانون الأول/نوفمبر إلى 7 كانون الثاني/ديسمبر 2013. الدورة افتُتِحت بعرض فيلم “رَام – لِيلَا” (RAM-LEELA) لمنتجه ومخرجه الهندي “سانجاي ليلا بانسالي”، وهو فيلم يسير عكس توجُّه المهرجان الذي طالما صَرَّحَ المشرفون عليه بأنه يسعى إلى الاحتفاء بسينما المؤلِّف عبر العالم عوضاً عن السينما التجارية.
انطلقت المسابقة الرسمية التي ترأَّس لجنة تحكيمها المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي بالفيلم الإسباني «الجري وراء الأوهام» للمخرج الشاب خوناسْ تريباابن المنتج والمخرج المعروف فِرْناندو تريبا الذي يناقش – بالأبيض والأسود – نهاية السينما والحبّ معاً. والفيلم الإيطالي «تحيا الحرية» للمخرجروبيرتو أندو الذي يسخر من السياسة وحياة السياسيين. وبهذا تكون صدفة البرمجة قد أعلنت ما سيطبع هذه الدورة.
عرفت المسابقة الرسمية للمهرجان مشاركة خمسة عشر فيلماً تمثِّل تجارب ومدارس سينمائية مختلفة، وهي في الغالب تمثِّل العمل الأول أو الثاني لأصحابها. وفي الوقت الذي يصرح فيه المنظمون بأن السينما المغربية حاضرة في مسابقة هذه الدورة فإن هذا الحضور لم يتجاوز فيلمين من إنتاج مشترك، وهما: “الحمى” لهشام عيوش، و«خونة» للمخرج الأميركي شين كوليت، مما يعني، إقصاء أهم الأفلام المغربية التي ذهب أصحابها للمشاركة في مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي يحتفي بالسينما العربية، وهذا دليل على أن المصفاة الفرنكوفونية تتطلَّب المرور عبر موزِّع أو منتج فرنسي، وهو حال كل الأفلام المشاركة في مهرجان مراكش. يظل إذاً، حضور الأفلام العربية، وكذا الإفريقية، هامشياً إن لم نقل شبه غائب، خاصة أن بعض الحاضرين بالمهرجان يرغبون، مثلاً، في اكتشاف بعض التجارب الإفريقية كما صَرَّح بذلك المخرج التركي الألماني فاتح أكين. عموماً، فقد عرفت مختلف فقرات هذه الدورة من مهرجان مراكش عرض أكثر من مئة وعشرة أفلاما تمثِّل ثلاثاً وعشرين دولة.
من الفقرات الملفتة والداعية للاحتجاج، فقرة «خفقة قلب» التي أراد بها المنظِّمون الاحتفاء بالسينما المغربية من خلال برمجة الأفلام التالية: “خلف الأبواب المغلقة” لمحمد عهد بنسودة، و«كان يا ما كان» لسعيد ك. الناصري، و«سارة» لسعيد الناصري، و«هم الكلاب» لهشام العسري… وهي أفلام مختلفة في أساليبها، وموضوعاتها، ولا تقدِّم في مجملها صورة واضحة عن منجزات السينما المغربية التي تُشَكِّلُ، اليوم، بعض تجاربها إشراقة فنية في إفريقيا والعالم العربي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل الأفلام التي تمرّ في هذه الفقرة تخضع للعلاقة مع الفرنسيين أو الدائرين في فلكهم، ولابُدَّ أن تقدِّم مواضيع خاصة، وتنطق بلغة معينة. أليس من المفروض أن يكون حضور البلد المُنَظِّم قويّاً حتى يتسنّى للزوّار اكتشافه من خلال سينماه، وألا يأخذوا صورة مشوهة عنه؟
وككلّ سنة احتفى المهرجان بنجوم السينما، وكَرَّم بعض تجاربها المكرّسة في كل من (إيطاليا، مصر، إسبانيا، وفرنسا…). كما وقع الاختيار على السينما الإسكندنافية ممثَّلة بكل من السويد، والدانمارك، وإيسلندا، وفنلندا، والنرويج؛ إذ شاهد الجمهور أفلاماً متنوِّعة من توقيع مخرجين ذوي حساسيّات مختلفة ينتمون إلى مدارس وتيارات سينمائية متمايزة من بينهم: «كارل تيودور دراير» و«آكي كوريسماكي» و«إنغمار برغمان» وغيرهم… أما بخصوص السينمائيين المكرَّمين، فقد كرَّم المهرجان الممثِّلة الأميركية «شارون ستون»، والفرنسية «جولييت بينوش» والمخرج الكوري «كور- إيدا هيروكازو»، والسينمائي الأرجنتيني «فرناندو سولاناس»، والممثِّل المغربي «محمد خيي» الذي لم يكن محظوظاً في أثناء تكريمه بفضل برمجة فيلم مغربي لم يمثِّل فيه، ولا علاقة له بأسلوبه الفني، وهو الأمر الذي خلَّفَ استياء بالغاً لدى المهتمين خاصة وأن الرجل أغنى المشهد السمعي البصري المغربي بعطائه الفني المتميّز، ومن حقِّه أن يتقاسم مع الحاضرين – في أثناء هذه اللحظة الرمزية – من النقاد والمهنيين والمعجبين فيلماً يُبْرِزُ مستوى قدراته التشخيصية.
وفي إطار فقرة الـ(ماستر كلاس) أو دروس السينما كان للجمهور لقاءات مع كل من المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي «برونو ديمون»، والمخرج والمنتج الأميركي «جيمس كراي»، والمخرج والمنتج الدانماركي «نيكولاس ويندينك ريفن»، والفيلسوف الفرنسي «ريجيس دوبري» الذي قال بأن السينما تدفع نحو الحلم، وهي ليست مُجَرَّد مسدَّس أو سيارة… وقد عرفت هذه الفقرة إقبالاً خاصاً من طرف النقّاد والأكاديميين والطلبة الذين يهتمّ المهرجان بإنتاجاتهم من خلال مسابقة “سينما المدارس” التي عرفت تتويج فيلم «بَادْ» للطالبين أيوب لهنود، وعلاء أكعبون عن المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش التي تسيطر على أطوار هذه المسابقة من خلال مساهمتها بخمسة أفلام من أصل تسعة.
وجاءت جوائز المهرجان كالتالي: فيلم «هان كونك جو» للمخرج لي سو جين من كوريا الجنوبية فاز بالنجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) للمهرجان، وتَقَاسَمَ فيلمي: «الدمار الأزرق» للمخرج جيريمي سولنيي، و«حوض السباحة» للمخرج كارلوس ماتشادو كوينتيلا جائزة لجنة التحكيم، وعادت جائزة أحسن دور نسائي للممثِّلة السويدية أليسيا فيكوندير عن دورها في فيلم «الفندق» للمخرجة ليزا لون كسيت، وفاز الممثِّلان ديديي ميشون، وسليمان دازي بجائزة التشخيص الرجالي عن فيلم «الحمى» للمخرج هشام عيوش…
يختتم المهرجان دورته هاته بمزيد من الانتقادات التي تقرّ بالضعف البَيِّنِ لأفلام المسابقة الرسمية، وترى بأنه يسير نحو الانغلاق على ذاته، خاصة وأن المهنيين لا يجدون مكاناً خاصاً للتواصل، وكذا لتسويق إبداعاتهم. فضلاً عن إبعاد كل المنتقدين للمهرجان، وخاصة النقاد الذين تخصّهم المهرجانات الكبرى بعروض وامتيازات خاصة. أضف إلى ذلك هيمنة التوجُّهات الفرنكوفونية التي تُهَمِّشُ اللغة العربية في عقر دارها، وتجعل الفرنسية اللغة الأولى للمهرجان لاسيما وأن كل السندات الخاصة به تَكُون فيها الأبرز والأوضح، وهنا لابُدَّ من استيعاب درس ريجيس دوبري حين أفاد بأنه يمكن للصورة والسينما أن يضطلعا بوظيفةٍ تَخْدُمُ الاستعمار والغزو واقتلاع الثقافات، وذلك ما تقف ضده بعض الأصوات المستقلّة التي ترغب في أن تتكفَّل الأطر المغربية بإدارة المهرجان كي لا يصبح في مهبّ الفرنكوفونية التي تُسْتَعْمَلُ كغطاء مدني لتثبيت الهيمنة الجديدة، وتُسَخِّرُ عرّابيها وأدرعها لتقويض أسس الثقافة الوطنية.
سينما – كل شيء عن مهرجان المدينة القرميدية
مراكش – هوفيك حبشيان
اختتمت مساء السبت الماضي الدورة الثالثة عشرة لمهرجان مراكش السينمائي (29 تشرين الثاني – 7 كانون الاول). تُوِّج الفيلم الكوري الجنوبي “هان كونك جو” لمخرجه لي سو جين بجائزة “النجمة الذهبية” التي نالها العام الماضي زياد دويري عن فيلمه “الصدمة” المستبعد من البلدان العربية. طالبة في المدرسة الثانوية تجد نفسها متورطة في قصة دنيئة تجبرها على تغيير المدرسة التي ترتادها. هذا ما يرويه الفيلم الفائز، وهو الاول لصاحبه (سبق أن نال جائزة في مهرجان بوسان).
من بين 15 فيلماً تسابقت في المسابقة الرسمية، كان على رئيس لجنة التحكيم مارتن سكورسيزي وفريقه اختيار عنوان وتوجيه الانظار اليه. التشكيلة المراكشية نالت رضا مخرج “الثور الهائج” الذي قال انه مطمئن لمستقبل السينما ما دامت الافلام بهذه المستوى. الخيار لا شكّ كان صعباً، فالأعمال المطروحة تنطوي على قدر معين من التنوع. مستوياتها متفاوتة وكذا بالنسبة للاتجاهات التي تفرعت منها هذه الأفلام التي ترتكز على الأصوات الجديدة. لا يمكن القبض على هذه الافلام من دون ان يتمرد بعضها على الاصابع. فالمسابقة المراكشية هي عموماً منصة لأفلام اولى او ثانية لم يُفسح لها المجال للانطلاق في مهرجانات كبيرة ككانّ او برلين. معظمها أعمال تنتمي الى تيار سينما المؤلف، بعضها تجارب غير مرضية او غير مكتملة العناصر، وبعضها الآخر ولد من خط سينمائي ينبغي تحريره من المعوقات.
من الأفلام التي يمكن ادراجها في هذا الاطار (اطار النوعية العالية): “ايدا” للبولوني فابيل فابليكوفسكي الذي يأتينا بصيغة حكائية مختلفة – بالأبيض والأسود البديعين – محورها راهبة شابة تريد الالتحاق بالكنيسة الكاثوليكية، ولكن قبل ذلك تزور خالتها التي لم تكن تعرف بوجودها الى اليوم، ما يضعها ويضعنا في مواجهة حقائق مذهلة تتسرب من الماضي. هذا واحد من النماذج المختارة في مسابقة مراكش هذه السنة، مسابقة استقطبت أفلاماً من كوريا وأسوج واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا واسبانيا، الخ. هناك ايضاً فيلم من طراز “تحيا الحرية” للايطالي روبرتو اندو الذي يستبدل في فيلمه هذا، أميناً عاماً لحزب معارض بأخيه، لقول بعض الحقائق عن السياسة وما يدور في كواليسها من أمور تراجيكوميدية. والى ذلك نجد ايضاً “شَعر قبيح” للفنزويلية ماريانا روندون المتمحور على صبي في التاسعة من عمره.
بيد ان ما اعتُمد كأفلام مغربية في المسابقة هو الذي صار محلاً للاشكال منذ سنوات في المهرجان. “هل هذه الأفلام تمثل فعلاً السينما المغربية؟”، بهذه الجملة الديماغوجية يبدأ أعداء المهرجان (هم ليسوا قلة) بتسجيل اعتراضهم على ما يجري ضمه من افلام مغربية الى التظاهرة السينمائية الاهم في البلد. كأن الأفلام الايطالية في مسابقة البندقية تمثل السينما الايطالية، وكذا بالنسبة للأفلام الألمانية في برلين والأفلام الفرنسية في كانّ (المهرجان الذي يحظى في كثير من الأحيان بانتقادات مشابهة لتلك التي نراها في مراكش). فمنذ فترة، نلاحظ انه بدأت تتكون تحت اقلام بعض المغاربة نزعة شوفينية كانت سابقاً سمة بعض الأقلام المصرية التي تكتب عن السينما من زاوية وطنية قومية متعصبة.
في الحديث عن السينما المغربية، يتغاضى هؤلاء عن حقيقة انه لا يبقى هناك الا كمشة أفلام جيدة تعدّ على اصابع اليد الواحدة من اصل 20 تُنتج خلال عام واحد. مهرجان مراكش مهرجان دولي ذو همّ كوني في زمن تداخل الثقافات، ولا تنحصر مهمته في دعم السينما المغربية ولا أي سينما دون سواها، بل يشتغل على اعادة الناس الى الصالات المظلمة لمشاهدة أفلام قليلة العرض والانتشار، في بلد يصعب فيه انجاز تلك المهمة بسبب القدرة الشرائية وتقلص الصالات والقرصنة. على الرغم من ذلك، فالمهرجان يمنح ارضا للانتاج المحلي، من خلال ادراج فيلمين مغربيين في المسابقة وتخصيص حيز يدعى “نبضة قلب” تضمن هذه السنة اربعة أفلام مغربية، أحدها فيلم “هُم الكلاب” لهشام لعسري الذي سبق ان وقّع فيلماً كبيراً عنوانه “النهاية”، وها هو يواصل تجربته المميزة هنا مع حكاية معتقل يخرج من السجن بعدما قبع فيه لمدة 30 عاماً.
اذاً، كيفية الاعتراض على تمثيل السينما المغربية في المهرجان، على الرغم من أهمية خوض النقاش فيها، ليست دائماً بريئة، بل تتفرز نتيجة صراعات وتجاذبات مرتبطة بإصرار بعض النقاد على اعتبار “مراكش” مهرجانا كولونياليا ينظم في باريس وينفذ على ارض المغرب (التهمة التي رفضها نائب الرئيس المنتدب نور الدين الصايل شارحاً تركيبة المهرجان المستند الى تعاون مغربي فرنسي)، ولا بد ان يكون هناك كنتيجة مباشرة لهذا الأمر، تلاعبات ومؤامرات شيطانية تحاك في الكواليس ضد فقراء العشوائيات واللغة العربية.
بيد ان النقد شيء و”أبلسة” المهرجان في كل ما يقوم به شيء آخر، وخصوصاً ممن لم تطأ اقدامه “قصر المؤتمرات” في شهر كانون الثاني من كل عام، وهو شيء بات مملاً ومثيراً للسخرية من فرط تكراره وعدم مقارعة الحجة بالحجة. “المهرجان فرنسي كثيراً”، يقول صحافي يغطي المهرجان للمرة الاولى، مذكّراً برد الملك على موزار: “ثمة الكثير من النوتات في الموسيقى التي تؤلفها”. أياً يكن، على الادارة ان تدخل الاصلاحات في بعض الامور التنظيمية (ولاسيما لجعل الناس يشعرون بأن هذا المهرجان يعنيهم)، ولكن على الصحافة المغربية في المقابل أن تعيد النظر في نفسها وفي اهداف وجودها في تظاهرة ثقافية، مثلما بات ملحاً على الصحافة السينمائية العربية ان تعيد النظر في مناهج النقد المتبعة وفي المعايير التي تطبق لتقييم المهرجانات.
الى ذلك، أكثر ما اثار اعتزاز منظمي المهرجان هذه السنة، هو عدد الوافدين من قامات سينمائية كبرى الى المدينة القرميدية. “حتى في كانّ، لا يأتون بلجنة تحكيم كهذه”، قال لي احد العناصر الذي يهتم بالصحافة الأجنبية في حديثنا عن الجهة المكلفة اسناد الجوائز للفائزين. فلجنة التحكيم، الى تنوع اعضائها، تكونت من ارفع ما جيء به في لجنة واحدة ضمن أي مهرجان عربي: التركي فاتي أكين، الأميركية باتريشيا كلاركسون، الفرنسية ماريون كوتيار، المكسيكي أمات اسكالانتي، الايرانية غولشيفته فرهاني، الهندي انوراك كاشياب، الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، الايطالي باولو سورنتينو (بالاضافة الى المغربية نرجيس النجار!). كل هؤلاء تحت جناج مارتن سكورسيزي الذي كان قرر الا يترأس أي لجنة تحكيم لو لم يتمكن المهرجان من اقناعه بالعزوف عن هذا القرار.
مارتي “قصة كبيرة” في هذا المهرجان. فهو زار المدينة مراراً، وصوّر في المغرب مرتين، وتربطه به أكثر من مجرد علاقة ضيف بمستضيف. انه فنان مرحب به من ارفع المناصب، ينزل في فندق “روايال منصور” خلافاً لبقية اعضاء لجنة التحكيم، وله حتى يد في التوسط مع شارون ستون كي تحضر حفل تكريمها ليلة الافتتاح. بعض الذين اصطفوا الى جانبه في لجنة التحكيم، كانوا من أشد المعجبين به في عمر المراهقة، مثل فاتي أكين الذي أخبرني بأن وجوده مع مارتي في لجنة تحكيم واحدة عبارة عن حلم. المكرمون أيضاً ليسوا أبناء اليوم. فواحدة منهم جولييت بينوش التي قدمت أخيراً دور عمرها في “كاميّ كلوديل” لبرونو دومون، والآخر هيروكازو كوريه ايدا، المخرج الياباني الذي قدّم اخيراً في كانّ فيلمه الجميل “كالأب كالإبن”، بالاضافة الى المخرج الارجنتيني فرناندو سولاناس، المناضل السياسي الذي حمل الكاميرا كما حمل غيره القذائف والصواريخ.
في عداد المكرمين أيضاً الممثل المغربي محمد خيي، الذي يا للغرابة قال ذات مرة انه “ليس لديه فرق بين المسرح والسينما والتلفزيون”. كل هؤلاء ليسوا من رموز الماضي الغابر وليسوا من الذين خفت نجمهم فصار الاتيان بهم سهلاً، كما كانت تفعل مهرجانات أخرى كدمشق أو القاهرة. فبينوش لا تزال في ذروة عطائها ولا يزال كوريه ايدا في قمة امكاناته الاخراجية ولا يزال نيكولاس ويندينغ رفن أو جيمس غراي أو برونو دومون (الثلاثة شاركوا في ما يسمّى “ماستركلاس”) من السينمائيين الذين لا يزالون تحت الاضواء، لا بل أن بعضهم كسكورسيزي يقف على بُعد ايام قليلة من مباشرة الحملة الترويجية لفيلمه الجديد “ذئب وول ستريت”. على مسافة ليست ببعيدة عن بدء العمل على فيلمه “الايرلندي” الذي سيجمع مجدداً روبرت دو نيرو (تاسع تعاون مع مارتي) بآل باتشينو. في مقابل الهرج المعتاد من المدعوين الفرنسيين الذين لا يأتون سوى للبهرجة واثبات الوجود، ومنهم من أفل نجمه منذ زمن طويل، ليس مفاجئاً أن نرى في مراكش احد اقطاب الانتاج في العالم، هارفي واينستين، مؤسس “ميراماكس”، وقد جاء لمواكبة عرض فيلم “فرصة وحيدة” لديفيد فرانكل. عباس كيارستمي هو الوحيد الذي تغيّب عن اللقاء لأسباب لم نعرفها، اذ كان منتظراً ان يلقي “درس السينما”.
من التكريمات التي شرعت الفضاء المراكشي على بقع جغرافية بعيدة، تلك التي خُصصت للسينما الاسكندينافية: نحو 50 فيلماً من الدانمارك وأسوج وفنلندا والنروج عرضت في هذه الخانة، ظللتها احدى كلاسيكيات السينما، “آلام جان دارك” (1928) لكارل تيودور دراير، مع الوجه المضيء لماريا فالكونيتي. ولم ينس المهرجان في هذا البرنامج الالتفات الى الرمز الأكبر لتلك السينما، أي انغمار برغمان، من خلال عرض أعمال له منها فيلمه الأخير “ساراباند”. في هذه المناسبة، وصل الى مراكش وفد اسكندينافي من نحو 40 شخصاً برئاسة بيل أوغوست (صاحب “سعفتين” في كانّ) وكان من ضمنهم نيكولاس ويندينغ رفن الذي قدّم معرفته السينمائية في لقاء مع الجمهور المغربي، واتيحت لـ”النهار” محاروته في شأن فيلمه الجديد “وحده الله يغفر” – حالياً في صالة “متروبوليس”. من الوافدين أيضاً من تلك المنطقة: توبياس ليندهولم، صاحب “اختطاف”، احد أفضل أفلام العام الماضي. فكانت هبة رياح شمالية ناعمة على هذا المهرجان الذي شكا من بعض الجفاف المبكر هذه السنة في البقعة التي حضنته، ساهم في تعزيزه اقفال فندق “منصور الذهبي” لأعمال الترميم، فتوزع الضيوف على الفنادق المتوافرة في المدينة ما قطع حبل التواصل بينهم.
مهرجان مراكش السينمائي:هل راكم ثقافة سينمائية غير مهرجانية؟*
-سعيـد بوخليـط-
(1) هناك، فرق شاسع وهائل،بين وضع السينما لما تتجمّل بمختلف المساحيق المصطنعة،فوق السجاد الأحمر،ثم واقع حال هاته السينما ! . ماهي، مستويات تجليات الحقيقة بين الإخراج السينمائي للقطات هؤلاء السينمائيين والسينمائيات،وهم يصطنعون التبختر أمام الكاميرات المشتعلة،يتطاولون زيفا فوق البساط، يتوخى كل منهم أن ترميه أقصى درجات انتباه الآخرين،يعرضون ويبسطن بسخاء شحمهم ولحمهم وآخر فتوحات تسوقهم،ثم ما استجد في أدبيات الديونتولوجيا ،من دبلوماسية الابتسامات والتحايا والإشارات وتحريك الشفاه والقسمات واستعمال لمفردات بعينها وتغنج وتدلل وتفكه وغمز ولمز وتقليص أو إرخاء للأسارير، والترجل من سيارات على الطريقة الإمبراطورية ،بحيث يتبدى لدى هؤلاء،كل بطريقته توضيبا سينمائيا لإيتكيت يحاول استعراض مقاييس مخملية للتحضر الآدمي؟ثم كنه، دائما هؤلاء،عندما يطوى السجاد الأحمر،وتنطفئ الكاميرات،ويفرغون إلى وجود عرائهم الأرضي؟فهل يستمر نبل السينما وشفافية الفنان السينمائي،منهجا دؤوبا ونبراسا قويما،ثم يكف شخص البهرجة المبرمج،لكي يبدأ الإنسان بكل ماتحمله الكلمة من دلالة،… .
الدرس الأول للفن عامة والسينما خاصة: أن تكون ذاتك، بكل تفاصيلها.
(2) حتما، لامجال للمقارنة بين السجاد الأحمر كما يتمدد في أوروبا وأمريكا،ثم مثيله هنا وباقي جغرافية العالم العربي.السجاد الأحمر،هناك لايقف عند كونه مجرد قطعة قماش من النسيج، يلقى بها ارتجاليا وسط خضم مفارق لواقعه،بغية تسويق صورمركّبة. بل، يجسد فعلا لبنة جوهرية ضمن لبنات منظومة مجتمعية تسمو بالعقل الجمالي،تشتغل وتتكامل روافدها علميا وسياسيا واقتصاديا،حيث المجتمع ينعم ويتغنى زاخرا بأسباب الحياة،لذلك تراهم مقبلين على الحياة،بالتالي عشقهم للسينما،فيعكسون بصدق المقولة الشهيرة “من يحب الحياة يذهب إلى السينما”.الأخيرة، بدورها لاتقف عند حدود ترف فوقي زائد،تحدده الموسمية،والدواعي التجارية لكنه مشروع سوسيو-تربوي متجذر بين ثنايا التربة المحلية، كي يتصالح الناس مع أنفسهم وواقعهم.السينما،آلة لتكريس القيم الكبرى،التي يستحيل على المجموعة الاجتماعية العيش متجردتا منها.البساط الأحمر،في أوروبا وأمريكا،هو فلسفة استراحة لحظية وتوقف تأملي،من أجل إعادة قراءة عرض قسم من الذكاء المجتمعي خلال فترة من فتراته،لكن الأهم الارتقاء بالجماعة نحو درجة أرقى بخصوص تمثل واستيعاب وبلورة الحس الجمالي،مما ينحو بنا صوب الدرس السينمائي الثاني :لكي تستمر السينما تشييدا للجمال، وإغناء زخم الجوانب الآدمية،فعليها أن تجد بالموازاة،كي تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل،مجتمعا يستمتع بوجوده،يعيش، يعشق، يحلم ويبادر.
(3) أيضا في أوروبا وأمريكا،لاتتحقق الأشياء بين عشية وضحاها،تحت الطاولة،بالتالي لايمكن مثلا لعمود خشبي أن يغدو ببساطة شجرة فيحاء.الفرص “مطروحة في الطريق”،محكومة بالكفاءة ولا تنتشل غفلة أو حيفا.لذلك،لا يمكن لأي احتلال موقع ما بأية طريقة، بل ينبغي عليه أن يقنع بعطائه وإبداعه.الفنان عامة والسينمائي بين طياته،مؤسسة مكتملة قائمة الذات،سلطة نافذة تحظى بنفس القوة المادية والاعتبارية لباقي السلط الأخرى،إنه ليس مجرد عارض على الهامش،أو لاعب قابع فوق كرسي الاحتياط،يترقب فجوة الانسلال إلى السجاد الأحمر،فيتلوى يمنة ويسرة،عسى أن تجود عليه الجرائد بصور تسويقية صبيحة اليوم التالي.إذن،الدرس السينمائي الثالث:الفنان إما مبدع أوغير مبدع.المبرر الوحيد،لامتطائه ذاك السجاد ،ما يجره خلفه من أثر ثم نوعية القيم التي أغنى بها مجتمعه، فالفنان موقف متكامل،رؤية وممارسة.
(4) هوية النجم السينمائي،ليست بالتحديد التجاري أو الاستهلاكي والدعائي،ثم قبل ذلك،ليس هو بالتعريف المنتهي.النجم بالنسبة إلي،قد لايكون هو نفسه عندك أو لدى الآخر،لذلك يستحيل تعميم نموذجه على الأقل بمنطق الاستسهال الذي نعانيه هنا.نحن اليوم،رغم الاتساع الهائل للمنابر الصحفية،لا نتوفر على نقد فني وفق معاير النقد الأكاديمي، مما يضعف ثقافتنا الجمالية وفي إطارها تذوقنا للسينما،إضافة إلى غياب هذه المسحة الشاعرية عن المنظومة التعليمية في مدارسنا. لنستدل بمراكش،أي موقع يحتله الفضاء السينمائي على امتداد يوميات هذه المدينة،قبل المهرجان وبعده؟مدينة بقاعتين سينمائيتين أو ثلاث !!الأنكى، في الضواحي التي لا تبعد عنها بساعتين زمانيا، لم يتمثل التلاميذ قط مرة واحدة في حياتهم وقد بلغوا مستويات الثانوي، ظلمة قاعة سينمائية،بل لايعرفون معنى لشيء اسمه السينما.إذن، من بوسعه في خضم صحراء معرفية ،التباهي أنه نجم بالتصنيف الموضوعي للكلمة؟في هكذا سياق، تصنع النجومية ورقيا،وتنتهي كذلك،فكلما تطلعت إلى ما يفترض أنه صفحات فنية،إلا وأصابك غثيان التفاهة: هذه تزوجت،تلك لم تتزوج،ذاك غرد فيسبوكيا ليخبرنا بأنه في الحمام ، تلك تدثرت، أخرى ألقت بثيابها جانبا،هذه حامل،ذاك دونجوان تتساقط عليه النساء كأوراق الخريف،إلخ،يا أخي ماذا يهمني أنا من كل هاته الترهات؟؟أين المتن المبدع؟.تقفز ذاكرتي حاليا،صوب أواخر الثمانينات وبداية التسعينات،عندما كانت جريدة “العلم”،تتحفنا كل يوم أحد بملفات عن السينما العربية والعالمية. كم استمعت !!
أنا وأصدقائي في مقهى ماطيش الشعبية بجامع الفنا، متحلقين ومحلقين على مقالات خالد الخضري وأحمد السجلماسي، نحو العوالم السينمائية الرائعة ل: بازوليني، فيليني، أكيرا كوروساوا، كلود لولوش، ستيفن سبيلبرغ، سكور سيزي،وحيد سيف،شادي عبد السلام، يوسف شاهين،محمد الركاب،محمد عصفور،محمد الدرقاوي،نبيل لحلو،وغيرهم.ثم حين العودة إلى منازلنا،سيكمل كل واحد منا تضاريس حلمه حميميا مع صمت الليل، على وقع البرنامج التلفزي لنور الدين الصايل “سينما منتصف الليل”. اليوم، ومع كل اللغط، يسود إعلامنا بمختلف مكوناته،توجها فنيا في غاية التبخيس والضحالة.الدرس السينمائي الرابع:كيف يمكن خلق سينما بدون ثقافة سينمائية قوية؟
(5) ليس كل من يلاحق خطاه فوق سجاد أحمر،بالممثل البارع المحترف المتمكن من أدواته،الذي يؤدي ويقنع،بالتالي يكون السجاد بمثابة منصة تتويج فعلية لمنجزه الفني وليس الشفوي،واستراحة محارب في انتظار الاستحقاق المقبل.بل جحافل كبيرة من هؤلاء، ألفوا هكذا لعبة التمثيل على أنهم يمثلون.فإذا كان واقعنا الفني جراء عوامل كثيرة،لا ينجب مع كل مرة ممثلا فنيا جديرا بالوصف،فعلى العكس من هذا،صار واقعنا اليومي ورشا خصبا لتكوين ممثلين حقيقيين وكومبارس،يتقمصون الأدوار الموكلة إليهم،بتشخيص تتفاوت مستوياته كما يحدث في السينما،حسب الخبرة التي راكمها صاحبنا. ممثلون بإخراج سيئ في: السياسة والدين والثقافة والرياضة والإعلام، يتقنون البهلوانية من خلال فن ارتداء الأقنعة، يمسخون ملامحهم حسب القصد والمقام ومقتضيات العرض والطلب. الدرس السينمائي المطلق: منطلق السينما،واقع لايمثل، لكنه يمارس عنفوان الحياة.
عن موقع هسبريس
مهرجان الفيلم بمراكش .. عندما يصنع الأدباء سينماهم
-محمد بنعزيز-
ضمن الأنشطة الموازية لعروض الأفلام في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش احتضن فندق سوفتيل حيث تقيم أغلبية فرنسية طاولة مستطيلة حول علاقة الأدب بالسينما. وقد دخلت المكان دون أن يعترض طريقي أحد. تولت الروائية كاترين أنجولي التسيير. وقد تناول الكلمة على تلك الطاولة رئيسة تحرير مجلة الاكسبريس ماريان بايوت والناقد السينمائي في لوفيغارو إريك نوهوف ومدير المركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل والروائي والمخرج الفرنسي دافيد فوكينوس.
كانت المداخلات من مستوى عال عكست اطلاعا واحتكاكا بالموضوع.
هذا عرض للمداخلات التي كانت متقاطعة، لكني فصلتها لتظهر تصورات كل متحدث على حدة.
في البداية لاحظت ماريان بايوت Marianne Payot تزايد عدد الكتاب الذين ينتقلون من التعبير بالقلم إلى التعبير بالكاميرا. للتدليل على ذلك قالت إن برنار هنري ليفي كاتب وأخرج أفلاما. لكن لا يكون هذا الانتقال ناجحا دائما. وأضافت أن الرواية صارت “أكثر سينمائية” وذكرت أن هناك نصوصا اقتُبست وصُورت مرات عدة ولم تتمكن السينما من استنزافها لأنها نصوص قوية. واستنتجت أن الكتاب الذي يحول لفيلم يباع جيدا، وأشارت لرواية هاري بوتر.
أضافت المتحدثة أنه من السهل اقتباس رواية غير مشهورة لتصبح فيلما. هذه رواية لم تكن حياة قبل الفيلم. بينما تصوير رواية شهيرة يعرفها الجميع يخلق مشكلة للمخرج الذي يريد ضبط النص حسب رؤيته. فتكثر المقارنات بين الرواية والفيلم. وأكدت بايوت أنه لما يبيع الكاتب حقوق كتابه ليتحول إلى فيلم فلا يحق له أن يحتج لاحقا على تغيير عنوان الفيلم أو عدم الأمانة للنص. لكن مع ذلك تسجل المتحدثة أنه في كثير الحالات ساءت العلاقة بين الكاتب والمخرج بعد خروج الفيلم للجمهور.
من جهته نبه إريك نوهوف Eric Neuhoff المتخصص في السينما في جريدة لوفيغارو إلى أن الانتقال من الكتابة للسينما هو تغيير للغة، أي من الكلمة للصورة. وقد رفض أن ينتقل روائي من الرواية للإخراج دون أن يمر عبر محطة كتابة السيناريو. والسبب حسب وجهة نظر نوهوف هو أنه لا يوجد فيلم جيد دون سيناريو جيد.
ولاحظ الناقد الساخر أن السينما صارت تؤثر كثيرا على الكتابة، وقد صار الكتاب يكتبون بشكل أسرع، وصاروا ملزمين بتعلم الكثير من الأشياء. وروى نوهوف أن غودار اتجه إلى السينما لأنه فشل في حلمه ليصير روائيا فصار مخرجا. وقد زعم الناقد الفرنسي أن الكتاب ينتقلون من الكتابة للإخراج للقاء الممثلات. وقد ميز بين نوعين من الكتاب. هناك كتاب يرمتون في عالم السينما وآخرون يرتمون في الخواء.
بالنسبة للروائي دافيد فوكينوس David Foekinos الذي نشر ثمان روايات وقد قال له المخرجون أن رواية واحدة له فقط ( وهي La Délicatesse ) لديه قابلة للتحوّل للسينما. ثم طلب منه المنتجون أن يقوم بنفسه باقتباس روايته للسينما فرفض بشدة. لكن الرواية اقتبست من طرف سيناريت غيره. وأضاف أن ما يهمه في الاقتباس هو الحفاظ على روح الكتاب رغم وجود مشاهد مضافة للسيناريو ولم تكن في الرواية. ولاحظ المتحدث أن الفيلم يشاهد أكثر مما تقرأ الرواية لكنه يحب السرد الأدبي لا السرد السينمائي، وهو يرى أنه ليس لدى الكاتب الذي يتعامل مع الورقة قدرة على تسيير فريق من 50 شخصا أثناء التصوير. هذا يتطلب طاقة مختلفة. واستنتج:
سيخسر الكاتب الذي ينتقل للسينما الكثير. سيتعرض للكثير للهجومات.
وأضاف:
الانتقال من الكتابة للإخراج هو انتقال من الكلمة للصورة حتى وإن كان هناك في الأدب تصوير أيضا. وأكد أنه حتى عندما تكون الرواية مغمورة، وتقتبس وتصير مشهورة، فإنه مع ذلك لا يتم الاعتراف للفيلم بالفضل بل ينظر للرواية التي عرف بها كأصل.
وهنا المشكل في الاقتباس:
المقارنة المستمرة بين الرواية والفيلم.
الحل؟
يجب النظر للرواية وللفيلم كعملين فنيين مستقلين وبالتالي محاكمة كل واحد في ذاته وليس محاكمة الفيلم بالنظر للرواية. ولكن دافيد فوكينوس نسف ذلك حين ختم بقوله:
“حاليا يجري تصوير فيلم آخر مقتبس من روايتي وقد مررت بموقع التصوير ولم أتدخل لأنه إن نجح الفيلم فبفضل كتابي وإن فشل الفيلم فبسبب المخرج”
أما نور الدين الصايل فقد اعتبر الانتقال من الكتابة إلى الإخراج انتقالا من سجل فني إلى آخر وأكد أنه ليس للسجلين نفس الخيال. فالسينما تتطلب خيالا بصريا. وأوضح أنه يوجد في الأدب ما لا يصور، ما لا تلتقطه الكاميرا. وشبه المتحدث الانتقال من رواية إلى فيلم برحلة الوردة لتصير تفاحة. واعتبر أن الكفاءة السينمائية للكاتب ليست مضمونة، بدليل أن البعض نجحت كتبهم لكن لم يتمكنوا من تحقيق نفس النجاح في السينما.
وذكر المتحدث نماذج منها آلان روب غرييه الذي انتقل من الصفحة إلى البيليكيل pellicul. وأيضا برنار هنري ليفيه الذي يحب الناس كتابات ولا يحبون أفلامه…
سجل الصايل أن يمكن يمكن للفيلم أن يكون مشجعا على القراءة لأن المتفرج يريد أن يعرف، وحسب وجهة نظر المتحدث يفضل ان يكتب المخرجون في الجنريك “فيلم مستلهم من رواية كذا” من بدل القول اننا صورنا رواية اندري جيد مثلا. وأكد الصايل أنه لا يحق للكاتب أن يملي على المخرج ما سيُصوّر.
لم يحضر نبيل عيوش كما كان مقررا للحديث عن تحويل رواية “نجوم سيدي مومن” لماحي بنبين إلى فيلم. لذا وجد الصايل نفسه مضطرا للحديث بدل عيوش، قال إنه “نجوم سيدي مومن” رواية موضوعاتية تتناول العنف الإسلامي عندما يصير جهاديا. وكشف أن ماحي بنبين قال إن روايته ما عادت تنتمي له بعد اقتباسها.
للخروج بخلاصة للنقاش قال الصايل إن المشكل ليس في الرواية أو الفيلم بل في قوة أو ضعف السيناريست الذي قام بالاقتباس، وقد سخر من السنارسيت الذي يتصرف ويعتبر نفسه كاتبا. قال أن هذا يرعبه ولا توجد جائزة نوبل لكتاب السيناريو.
مراكش الباردة “وعادت حليمة إلى عاداتها”
-خليل الدامون-
بعد يومين أو ثلاثة من الأفلام المقبولة في مهرجان دولي كمهرجان مراكش أصبحنا نشاهد افلاما من الدرجة الثالثة والرابعة (الأفلام المغربية من الدرجة غير مصنفة) لأنك حين تتحدث عن الأفلام المغربية بروح نقدية (لا انتقادية) تصبح إنسانا لا وطنيا الآن بدأ المنظمون يعقدون جلسات هنا وهناك لم تكن مبرمجة وكأنها جلسات سرية لا يحضرها إلا من هم مكلفون بالتبليغ. (فليبلغ الحاضر منكم الغائب) مثلهم مثل البراح في عصورنا الغابرة. جلسات نفهم منها – حسب المبلغين طبعا – وحسب مصادر موثوقة – أن المنظمين في ورطة. من اختار هذه الأفلام؟ أو من له صلاحية الاختيار في هذه المهرجان؟ هل هو المدير الفني وهو للتذكير من أتباع المديرة العامة، أم هو نائب رئيس المؤسسة الحامل للجنسية المغربية؟ يبدو كذلك أن مجموعة من الجلسات لم تكن مبرمجة عقدت للإجابة عن مبرر غياب أي برنامج ثقافي منها تلك الجلسة حول السينما والأدب. الطريف أن هذه الندوات الصحفية والجلسات الثقافية يتكلف المبلغون بتبليغها بحيث تصلك أخبارها دون أن تبحث عنها. ومن الأفكار التي يوصلها المبلغون أيضا: “احمدوا الله على مهرجانكم وافرحوا به ودعموه ما دامت مهرجانات أخرى قد انقرضت أو هي في طريق الانقراض كمهرجان القاهرة ومهرجان قرطاج” بالعربي الفصيح: اقبلوا بما هو موجود وليس في الإمكان أحسن مما كان. الكل هنا في المهرجان: المخرجون، التقنيون، المنتجون… كلهم وبدون استثناء يشتكون بأن المهرجان لا يسمح لهم باللقاء مع زملائهم من دول أخرى بحيث أصبح المهرجان وكأنه جزر معزولة: المغاربة في فنادقهم، الفرنسيون في فنادق أخرى، الأمريكان في أخرى. الكبار في أخرى. لا يلتقي الناس إلا فوق البساط الأحمر للتصريح بأن كل شيء على أحسن ما يرام وبأن المغرب يكرم ضيوفه وبانه أجمل بلد في العالم. المأساة أن النقاد دائما وأبدا يتحملون تبعات وأوزار هذا الوضع وأنهم لو تحملوا مسؤوليتهم لكان المهرجان في وضعية أفضل. ألا تلاحظون أنني نسيت الأهم وهو الحديث عن الأفلام؟ لا بأس أكتفي بالنميمة هذه المرة ما دمنا في عصر النميمة.
على هامش الدرس السينمائي السادس لنور الدين الصايل بمراكش
-أحمد سيجلماسي-
كعادتها كل سنة ، وبمناسبة انعقاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ، استضافت كلية الآداب والعلوم الانسانية المراكشية من خلال شعبة الاجازة المهنية ” دراسات سينمائية وسمعية بصرية ” ، في اطار أنشطتها الثقافية ، المدير العام للمركز السينمائي المغربي الأستاذ نور الدين الصايل الذي ألقى درسا حول السينما عشية الثلاثاء ثالث دجنبر الجاري ، بحكم تجربته السينفيلية القديمة داخل الأندية السينمائية وحديثه عن الأفلام المختلفة في البرامج الاذاعية والتلفزيونية التي أعدها ونشطها بالاذاعة والتلفزة المغربية في أواخر السبعينات وعقد الثمانينات من القرن الماضي ، وبحكم معرفته بدواليب الانتاج الفيلموغرافي وبرمجة الأعمال الدرامية وغير ذلك عندما كان مديرا لقناة ” دوزيم ” المغربية وقبلها ” كنال بلوس أوريزون ” بفرنسا ، وبحكم معرفته الشاملة بقطاع السينما بالمغرب قبل وبعد تحمله مسؤولية تدبير شؤون الادارة الوصية على قطاعنا السينمائي من 2003 الى 2013 .
والملاحظ أن هذه الدروس الستة لم يتم تجميعها في مطبوع أو وثيقة سمعية بصرية لتشكل مرجعا لطلبة هذه الاجازة وغيرهم من المهتمين بالسينما وثقافتها . وهنا نتساءل : أليس بالامكان التنسيق مع ادارة ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش من أجل طبع كتيب أو اصدار ” دي في دي ” يتضمن هذه الدروس وغيرها من الدروس (الماستر كلاس) التي ينشطها سنويا ضيوف المهرجان من السينمائيين الكبار ككيروسطامي وسكورسيزي وغيرهما ؟
والى متى سيظل مهرجان مراكش الدولي ، الذي تصرف عليه الملايير ، عقيما على مستوى الاصدارات ؟ فباستثناء نشرته اليومية ” الأوفيسيال ” ، وباستثناء الكاتالوغ الرسمي ، لم يستطع طيلة تاريخه المديد (13 سنة) أن يصدر ولو كتابا أنيقا واحدا يوثق بالكلمة والصورة لمختلف أنشطته وللأفلام التي شاركت في مسابقاته وللوجوه التي استضافها أو كرمها … أليس بامكانه مثلا أن يصدر مجلة سنوية محترمة توثق لكل دورة من دوراته ؟ أليس بامكانه اصدار سلسلة من الكتب الصغيرة يعرف كل منها بوجه من الوجوه المكرمة أو بسينما من سينمات العالم التي يختارها سنويا للتكريم أو بالأفلام الفائزة بجوائزه الخ الخ الخ … ؟
صحيح أن المهرجان المراكشي يتوفر على موقع الكتروني مقبول نسبيا ، يتضمن معطيات لابأس بها تتعلق بمختلف جوانبه ، لكن هذا الموقع وحده لا يشفع له اذ الملاحظ أن جوانب البهرجة والتبذير وغياب المردودية الثقافية وغيرها أمور أصبحت بادية للعيان ، فثقافيا يشكو المهرجان من فقر كبير بسبب تهميش الفاعلين المغاربة وغيرهم ، فلا تعقد ندوات وموائد مستديرة على هامشه ولا تناقش الأفلام المشاركة في مسابقاته ، ولا يتم التنسيق مع الجمعيات السينمائية الوطنية والفاعلين السينمائيين المغاربة لتنشيط بعض فقراته . نتمنى أن يعاد النظر في كثير من أمور مهرجاننا المراكشي الكبير ليصبح بحق مهرجانا مغربيا دوليا ومن صنع مغربي .
سُنن عبور البساط الأحمر
-محمد بنعزيز-
أضواء وحرس ومعرض حي على البساط الأحمر في افتتاح مهرجان مراكش السينمائي. النجوم فوق البساط السميك والبشر العاديون خلف السياج على الإسفلت. يكاد الجو يمطر، لذا فالنجوم في السماء أقل من النجوم على البساط. يصفق الجمهور لممثل تلفزيوني محلي أكثر مما يصفق لمرور مارتن سكورسيزي وكفه على خصر الإيرانية غولشيفته فاراهاني أو الفرنسية ماريون كوتيار…
نجمتان بقد ميّاس كما غازله صباح فخري. على البساط، يشكل الجسد الجميل نعمة أسطورية، كل من تكوّر بطنه وصار أعرض من كتفيه لا يثير الانتباه. ليلى حاتمي، بطلة فيلم «انفصال» كانت محتشمة. كل عام يحرص المنظمون على حضور نجمة إيرانية واحدة.
يبدو أن ذلك جزءاً من الاقتصاد السياسي للمهرجان.يسدد المصورون على الشابات اللواتي يكشفن الكثير من لحمهن. ويعتبر عدد الفلاشات التي تلمع علامة على أهمية عابر البساط. وبما أن التكرار يسبب الملل، فيجب على النجم أن يقدم الجديد في مروره اللاحق، ولا بد من الإثارة في اللباس والسلوك. لذلك أدخل المصممون تغييرات على القفطان المغربي فصار يشبه فستان السهرة، فيه فتحات كبيرة على الكتف والصدر والفخذين، وحين يكون أسود يليق أكثر بعابري البساط.
القفطان محتشم مقارنة مع الدانتيل الأسود الذي يستر ويكشف دفعة واحدة.هذا للنجمات. أما بالنسبة للنجوم، فتقتضي سُنن البساط أن يكونوا مرفوقين بقد ميّاس. الجديد في اليوم الرابع: زادت القبل على البساط. يبحث المصورون على قُبَل نارية، وقد خلدوها في صور عدة نجوم: يضع النجم كفه على القد الحلبي للنجمة ويطبع قبلة على خدها أمام الجماهير المنتشية.
مثلها مثل ابن الفارض الذي أنشد:
قدك الميّاس يا عمري – يا غصين البان كاليسر
أنت أحلى الناس في نظري – جلَّ من سواك يا قمري
هكذا يدرك المتصوف جلالة الخالق في تسوية القد الميّاس. وقد قال ابن عربي إن عظمة الله تدرك في خلق النساء أكثر مما تدرك في خلوة قمم الجبال. وسيراً على هذا النهج، وقف المخرج الأميركي الكبير مارتن سكورسيزي لتكريم شارون ستون واستشهد بنص رولان بارت عن وجه غريتا غاربو التي اعتبرها تجسيداً للجمال الأفلاطوني. قال بارت ذلك في كتاب «ميتولوجيا»، حيث كشف كيف تتحول ثقافة البرجوازية الصغيرة إلى ثقافة كونية. السينما هي التجلي الأعلى لهذا التحول، لذلك فإن أفراد البرجوازية الصغرى مثلي يشعرون برهبة أمام النجوم: سكورسيزي، شارون ستون، جولييت بينوش… أمام هذه الأسماء المُؤلّهة بتعبير بارت، يتعطل الحس النقدي لدى الجماهير المبتهجة بآلهة صغيرة فاتنة على البساط الأحمر. هكذا يزعم الفن تعويض الدين.صباح الغد مررت على البساط، كان مهجوراً بلا معنى. له لون لسان الكلب، وهو اللون الذي سحر زوجة فرعون.
بدءاً من السادسة مساء، نشط الاستعراض من جديد. العبور على البساط هو سقف النجاح، هو لحظة المجد. البساط فرصة للافتتان بالجمال. تتناسب مشية كوتيار وقول الأعشى في معلقته «غراء فرعاء مصقول عوارضها»، جمع جمال القد والوجه والشعر والابتسامة في شطر واحد.هذه هي سنن مرور النجوم على البساط. ما الذي يصنع النجم؟ الصورة أصدق إنباء من الكتب، في حدها الحد بين النجم والنكرة. توجد صور النجم في كل مكان، يحاصر معجبيه بصور تخلد لحظات حياته.
هكذا يصير اسم النجم طنانا. تتحقق الشهرة بالموهبة أو الفضيحة، وتكون الشهرة الحقيقية بالمنجز، بالعمل العميق والمؤثر. وتكون الشهرة الفورية بانتشار الصور بين الجماهير. الجماهير، بمفهوم كرة القدم لا في عرف اليسار. كلما تفاعلت الجماهير دل ذلك أن الصور حميمية، حالمة.لذلك فالجمهور الواقف على جنبات البساط مسلح بكاميرا ويلتقط صورا رقمية فورية من دون حاجة لغرفة سوداء وتحميض وورق، جمهور واثق أن كل من يمر على البساط موهوب. يسلم الرائي انه ليس من طينة المرئي، لكن الحلم ممكن، وحلم النجومية عدوى تصيب الواقفين حول البساط الأحمر.
في بعض الأحيان ينتحل النكرات صفة النجوم ويمرون على البساط، يحرصون على بعض الحركات البهلوانية لإثارة الانتباه. وهم بذلك يعرضون أنفسهم للسخرية، لأن النكرات معرضين للتعثر وحتى للسقوط على البساط ما داموا يراقبون مشيتهم بشدة.
هؤلاء معذورون، فأية مهانة أشد من أن يكون الفرد نكرة في عصر الصورة. لكن الجماهير تشعر بالإهانة حين تفاجأ بالنكرات على البساط وتتساءل: من هذا؟ من هذه؟ لتدقيق قوانين المرور على البساط توجهت لريجيس دوبريه الذي جاء لمراكش للحديث عن كتابه الأخير «مخدّر الصورة» Le stupéfiant image، سألته: المهرجان السينمائي هو أفلام وبساط أحمر. ما هي قوانين عبور البساط؟ أجاب: استفاد الديكتاتور من البساط الأحمر. كان مروره إشهارا.
المرور على البساط بالنسبة للسياسي لحظة تقديس وبروتوكول لبناء أسطورة القائد. لحظة يكون فيها العابر على البساط مختلفا عن الآخرين، فوقهم، مُؤلَّها. وأضاف دوبرييه الذي حلق شاربه الشهير إن السينما تبني الميتولوجيات، تبني هويات الأوطان، لأن السينما فن شعبي ونخبوي دفعة واحدة. وأكد أن للسينما وظيفة سياسية. هكذا كشف دوبريه الوجه الآخر للبساط الأحمر.
في هذه اللحظة التي تطوي مراكش بساطها تتسلم دبي المشعل لتقدم الوجه المشرق للخليج. اشتد التنافس العربي على الاستثمار في الاقتصاد السياسي للسينما. وبما أن مهرجانات دمشق والقاهرة وقرطاج جمعت بسطها، فإن مراكش ودبي تلمعان. وكلما زادت الفخامة وسلطة النجوم الحاضرين زاد العائد السياسي للبساط الأحمر.
حديث الفلسفة حول الصورة والسينما : نورالدين الصايل يحاور ريجيس دوبري
-عز الدين الوافي-
شهدت قاعة المؤتمرات ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي في دورته الثالثة عشر حدثا متميزا على مستوى تنظيم ماستر كلاس انتظره الكثيرون وذلك لما تشكله مثل هاته اللحظات الثقافية والفكرية من قيمة لدى عشاق السينما ومتتبعيها، وهي التي بمقدورها أن تمنح لأي تظاهرة ما عمقها الجمالي، وإن شئنا المعرفي بمعناه الصوفي.
من المعلوم أن المحاور غالبا ما يوجه منحى اللقاء بهواجسه هو، من خلال أسئلة قد تبدو له مهمة. وبالتالي يمكن القول أن نوعية الأسئلة وكيفية إثارة القضايا المرتبطة بإنتظارات المتتبع المختلفة مستويات معارفه وطرق إدراكه قد تتغير بمجرد ما يتغير الضيف والمحاور.
لذا، فإن اختيار المحاور مسألة جوهرية في عملية المحاورة لأنه المخول فلسفيا بدفع الضيف لبعث الحياة في الأفكار وفتح أبواب الفضول.لكن عندما تحاور الفلسفة السينما أو العكس فلا بأس بل هو أمر ضروري ومن المفروض أن يكون استهل الحوار بسؤال الصايل حول علاقة الفلسفة والميديالوجيا بالسينما في حياة دوبري
الذي اعتبر نفسه مجرد متسكعا في الفلسفة، وأن السينما بالنسبة له ابتدأت منذ زمن الطفولة من خلال الأفلام الوثائقية المعنونة باكتشاف العالم. من ثمة، تشكل لديه وعي حاد بأن السينما تعادل السفر والبحث والإستكشاف، وبأن الحياة الحقيقية هي فيما يوجد نوعا ما هناك في البعيد والمختلف
بعدها أشار دوبري لأفلام جون روش وسينماه الإثنوغرافية التي ميزت مرحلة تعلقه الأول بعالم الأفلام وكذا كتابات إدغار موران.
حينها أدرك دوبري أن العالم مسجل نوعا ما ويمكن حبسه من خلال منظار الكاميرا .فحمل كاميرا لإكتشاف أضواء العالم وسافر إلى فنزويلا.
غير أنه سرعان ما ترك الكاميرا وغير منظار الرؤية من جديد ليعيد اكتشاف العالم الفضي ليس باعتبار نفسه عاشقا للسينما، ولكن على حد تعبيره إبن السينما وذلك من خلال نسج علاقته الكلاسيكية بمجلات السينما حيث ذكر مجلة بوزيتيف ودفاتر السينما التي كان من روادها تروفو ورومر وغيرهما من الذين عرفوا وسمحوا للقارئ بالإطلاع على السينما الأمريكية
عاد دوبري ليذكر الصايل أن السينما من منظوره الخاص مسألة شبابية، وأنها تتطلب طاقة الشباب وحيويتهم متذكرا صباه حيث كان الشباب يتقمصون ذهنا وعاطفيا الشخصيات السينمائية وخصوصا في تلك الأفلام الأمريكية التي كان يمثل فيها غاري كوبر وجون وايني وهي التي طبعت مخيلة أجيال بكاملها.
هنا لمح الصايل لإمكانية اعتبار السينما كنوع من المخدر. ولكن دوبري استشهد للتعليق على ذلك بأندري بايار الذي كان يرى دائما أن السينما تدفع للحلم.
تابع دوبري حديثه عن كون السينما ليست مجرد مسدس وسيارة مستشهدا بالدور الذي قدمته السينما لتسجيل وتسييج الذاكرة الأوروبية من خلال أفلام المقاومة الفرنسية وبدايات السينما الإيطالية التي تركت في الإنسان الأوروبي تحديدا أثرا عميقا في تشكيل ذاكرته.
بعدها فتح الصايل آفاق الحوار حول خطورة الصورة وهو المجال الذي اشتغل عليه دوبري وألف فيه كتبا وخصوصا كتابه المعروف ب حياة الصورة وموتها هنا بالضبط غاص الضيف في أتون وتلافيف ظاهرة الصورة بمرجعياتها الثيولوجية والفلسفية معتبرا أن العالم اليوم أصبح بصريا، وأنه بإمكاننا الحديث عن تاريخ للنظرة مؤكدا على الأدوار والوظائف المتعددة التي يمكن للصورة أن تلعبها باعتبارها أولا ، خزانا للذاكرة ثانيا، لكونهاهروبا من الكآبة
ثالثا ،للصورة دائما حسب دوبري، علاقة بالموت فهي بمقدورها أن تميت وتبعث الحياة في الموتى،كما أن لها
علاقة بالكهف حيث سجل البدائي علاقته بالحيوان الأكبر منه حجما وقوة رابعا، وبالإضافة لهذا كله، فالصورة حسب المنظور التقليدي، هي حماية من الشر وجلبا للسعادة أو للشقاء. وأشار إلى مثالين إثنين مثال الإمبراطور الصيني الذي عانى من التذمر بسبب صورة نافورة تحرم عن جفنيه النوم فأمر العسكر بمحوها، ومثال آخر لأشخاص أشاروا بقطع صور الثعابين لأنها لا تعض بعد ذلك ذكر دوبري بالوظيفة الجمالية للصورة التي تجعل من الفن نوعا من المتعة.هناوضع الضيف ظاهرة الصورة في سياقها التاريخي وتحديدا في العالم المسيحي عندما لم يعد الإنسان الأوروبي يؤمن بالله ولم يعد يركع له حسب تعبيره.هنا برزت الوظيفة الجمالية للفن وذلك مع تبوء الفنان لمكان الخالق للعالم باعتباره فردا يوقع أعماله.وقد اعتبر الضيف ذلك حظا للثقافة الأوروبية التي نزعت عن الخالق قدسيته وخصوصا عندما سمح للفنان بتصوير الذات الإلهية التي تجسدت عبر جسد المسيح الإبن إبان سنة 787 وبالتالي تم تصوير أجساد القديسين دون خيانة الله. ويمزح دوبري قائلا أنه في هاته السنة ولدت هوليوود انتقل الضيف لوظيفة إضافية يمكن أن تضطلع بها الصورة والسينما وتتجلى في وظيفة الإستعمار والغزو واقتلاع الثقافات بل حتى الدعاية وهو ما فهمه الأمريكيون جيدا حيث اعتبروا أن الصورة يمكن أن تشكل وتساهم في صياغة رؤيتنا للتاريخ عبر إنتاج الأفلام مثلا.وقد استدل على ذلك من خلال المشهد المألوف والمتكرر بالنسبة للشباب حول الحرب العالمية الثانية التي تقتصر في نظر جلهم على وعبر نزول جيوش الأمريكان على شواطئ النورماندي مع تغييب الدور السوفييتي مثلا من خلال ذاكرة الصور لا يمكن لدوبري أن يغفل الوظيفة النضالية وهو المناضل اليساري مع الميليشيات في أمريكا اللاتينية إلى جانب المناضل شي كيفارا .وهي الوظيفة التي من المفروض أن تقوم بها الصورة في محاربة ما أسماه بالغزو الأمريكي للفضاء البصري للعالم في معرض حديثه عن ذلك أشار دوبري لـأراغون الذي اعتبر الصور من قلب الحداثة من إشهار وإعلانات في الشارع، وهو ما يمكن اعتباره ذو مهمتين :مهمة التخذير وهو ليس بالضرورة بالمعنى السلبي للكلمة حسب دوبري لما يشكل ذلك من إستكشاف حدود العالم، ثم مهمة الدفع والحث على التخييل.
هنا استطرد الصايل مجمل الوظائف التي سلف ذكرها مضيفا الوظيفة الإقتصادية ومذكرا بأهمية السينمات الوطنية والسينما المغربية ومدى القبول عليها في شباك التذاكر كلما تعلق الأمر بتشجيع المنتوج الوطني.
ذهب دوبري أبعد من ذلك عندما بين كيف أن الأمريكيين فهموا وأدركوا كنه الإبهار لذلك تمكنوا من اكتساح العالم
وقف دوبري في معرض حديثه عن أصل السينما ودور كل من الأخوين لوميير في تسهيل الإنتقال من الإنتاج اليدوي للصور إلى المسند الميكانيكي مشيرا إلى أهميته في إدراك الإنسان لذاته وللعالم،وهو ما شكل بالنسبة له إعلانا عن ظهور الفردانية دون المرور عبر يد المصور الفنان وقيام الآلة بذلك..
وأوضح ذلك من خلال نموذج صور بطاقات التعريف وصور المجلات التي لا يمكن أن تعيش بدون صور الأشخاص وميكانيزم التشخيص بل تعظيم الذات وأسطرتها كما هو حال بالنسبة للدكتاتور وللنجم اللذان يثبتا وجودهما من خلال تواجد الصور هنا وهناك في المجال العام والخاص شدد دوبري على طبيعة السينما في الجمع بين مختلف الفنون بدء بالبصريات والموسيقى وصولا الى الرسم و التمثيل.وحسبه دائما هناك نوع من الردة والردة أو الإنتقام المضاد وهو ما قادته الرسوم المتحركة إنتقاما لفنون الصباغة الزيتية التشخيصية.وهو ما تقوم به أيضا السينما والمسلسلات التلفزيونية. هنا أشار الضيف إلى فكرة هامة وتتجلى في كون كل تغير تقني هو تثوير وخلق لأنواع جديدة من الفن.لذا، فإن المناظر الطبيعية ظهرت على حيطان الكنائس أولا وتم تداولها عبر المسند الخشبي والأعمال الزيتية.تحول تقني آخر حصل مع ظهور فن الفيديو الذي بسبب معداته الرخيصة وسهولة الحصول على طاولة للمونتاج مكن الفنان من رؤية العالم من منظور آخر .وقد نبعت مثل هاته التجديدات من قاع المجتمعات وليس من مستوياتها العليا والراقية تساءل الصايل مع دوبري كيف سيكون بمقدور الرقمي أن يخلق فنونا أخرى غير فن الفيديو والرسوم المتحركة وغيرها من الوسائط والألعاب المخصصة للشباب والأطفال ولقد بين دوبري أن السينما أخذت نوعا من الوقت الكافي لتخلق شارلي شابلن كما أن الصباغة المسيحية أخذت وقتا كافيا لتخلق رموزها وعباقرتها أمثال فان كوخ وكارافاجيو. لذا وجب إعطاء الوقت للوقت وللتكنولوجيات الحديثة لتخلق ثقافتها ورموزها.
وأوضح الصايل من جديد قصده من التساؤل موضحا هل بفعل التطور الرقمي والميديالوجيابإمكاننا أن نشهد ميلاد نماذج سردية في الحكي أو في تقديم تسهيلات ما للمشاهد لإدراك الحكاية والمعاني ثم كان جواب دوبري قاطعا حين أعاد بنوع ما الفكرة متسائلا هل ما زال بمقدور السينما أنطولوجيا أن تقدم الحلم ثم مجيبا على تساؤله أن السينما هي نظرة للعالم لا مثيل لها لكونها تخرج من العقل وليس من القلب.وبالتالي، فالسينما هي شهادة على الواقع. غير أن المد الرقمي يقوم بفبركة حسابية خلال عملية إنتاج صور حول العالم.فالصورة باتت تحيل على ذاتها بالدرجة الأولى دافعة الناس لإدراك عوالم لأشياء غير مدركة..
الصور باتت حسب دوبري دائما، تخرج من ظلال متناسلة.والمثير في ذلك أن هناك أجساد تتحرك، وتقفز، وتتقدم لكن لا نظرة لها لكونها لا تتواصل. وهذه هي بالضبط نقطة ضعف فيلم أفاتار.
إن البعد الرقمي للمؤثرات التكنولوجية في أمثال هاته الأعمال يفقد جمالية اللقطة العريضة لكونها صور لأشخاص برؤوس من دون وجوه.وبالتالي، هناك نوع من التصنع الشكلي.
وذهب دوبري إلا أن مثل هذا الزخم بسبب قلة المصاريف قد يجعل الإنسان من دون صور أصلا وإذا ما تمادى الإنسان في إنتاج هذا السيل العارم من الصور التي من المفروض فيها أن تكون تجربة تأملية حول العالم فلاشك أننا سنفقد العالم ذاته.
حينئذ قد نعمد إلى استعادته عبر الكتاب بالرغم من قدرة الصورة على إدماج ما قيل من فنون النحث والفوتوغرافيا والصباغة في زمن وجيز جدا
..
هنا تحدث الصايل عن تجربته في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية حيث كان يجول ربوع المغرب لحمل نسخ من أفلام نادرة وتوزيعها ثم عرضها على جمهور من عشاق الفن السابع بنوع من المتعة واللذة.
مضيفا بنوع من التحسر على زمن النسخ والمسخ الميكانيكي، وهو ما أشار له والتر بنجامن، الذي لم يولد حسب الصايل سوى الجهل البصري مستدلا على
كلامه من خلال مثال أخذ شخص إلى أكبر مكتبة في العالم
وأن تقول له تفضل كل هذا لك.فإنه لن يعرف ماذا سيفعل بذلك الكم لأنه وإن رغب في المعرفة فستعوزه القدرة على تحديد ماذا يريد سلفا.
تدخل دوبري مذكرا بما أسماه بالبوصلة التي تنمو وتكبر عبر ما تقدمه المدرسة، لأن المشكل حسب دوبري والتي تقاطع فيها مع الصايل، ليست فيما ما نريد ولكن في تنظيم ومعرفة ما نريد.مستطردا أن الذاكرة تختار سياقاتها ونحن في أمس الحاجة للتربية على الصورة لأن هناك ما هائلا من المعارف والصور التي تسبح في العالم. وبالتالي، هناك نوع من الحيرة والتيه حول تاريخ الفن وتاريخ السينما.لذا لزم وجود مكتبات للصور وخزانات للأفلام وإلا فالجو سيخلو للسوق كي يملأ كل شيء الخزانات السينمائية مثلا لا تحفظ الذاكرة وتوفر المتعة فقط ،ولكنها تقوم بخلق مواطنين بذاكرة بصرية وهنا تحضرنا المهمة السياسية بالمعنين الإيجابي أو السلبي والتي يمكن أن تلعبها السينما.
هنا ذكر دوبري بالإستثناء الثقافي الذي شهدته ودافعت عنه فرنسا تجاه الغزو الأمريكي لمجتمعاتها عبر سوق الأفلام.كما شدد على دور السلطات العمومية في القيام بمهمة الدفاع عن الثقافة وذلك عبر توفير البنيات الضرورية ضد كل أشكال الإقتلاع الثقافي وحفاظا على الذاكرة من الضياع والإتلاف عاد دوبري ليتحسر بمرارة عن غياب البعد التكويني لدى العديد من الدول مؤكداعلى أن التربية هي مفتاح للثقافة، ومستشهدافي نفس الآن بأندري مالرو حين قال ان المدرسة والجامعة تعلمان لكن المتحف يجعلنا نحب.لذا وجب حسب دوبري المرور عبر التعلم لكن عبر الحب أيضا.
اليوم وفق منظور دوبري وامام سقوط الأيديولجيات وانهيار القيم الكبرى فالصورة باتت بحكم المواصفات التي تتمتع بها كاملة ومكتملة وقادرة على خطف ألباب عقولنا والرمي بنا في مصائد الاستهلاك وخلال حديث دوبري عن تاركوفسكي سأله الصايل هل إنتاج وتأمل التجربة الإخراجية لهذا المخرج الروسي ما زالت قابلة للتفكير.
حينها عبر دوبري عن أهمية السينمات الوطنية مشيرا إلى السينما الصينية والهندية وقدرتهما على تعزيز فكرة وذاكرة الوطن. فحسب دوبري لم يكن للأمريكيين ماض ووطن فمن خلق لهماذلك، السينما من خلال أفلام هنري فوندا وغيره من الممثلين والممثلات. بل خلقت السينما لأمريكا خلفية أخلاقية وبصرية.لذا فإنه من قبيل المستحيل التفكير في الأوطان دون ذكر السينما.لأنها المخولة والقادرة على خلق وتشكيل الهوية.
وبقدرتها على مخاطبة الشعبي والنخبوي ناهيك عن قدرة السينما على خلق أساطيرها خلص دوبري إلا أن العالم يشهد نوعا من التحول عبر ومن خلال اللعب بأشكال الوجوه والأشياء بواسطة تقنيات الفوتوشوب والصور التي باتت تنتج لا ذاكرة لها لأنه لا تثير الفكر والإبداع كحال المصورين الفوتوغرافيين الأوائل ككابا لذا وجب أخذ المسافة الضرورية وعدم الجري وراء السهل والمبتذل.
وهو ما عبر عنه الصايل من وجوب الرؤية لذا المبدع لأن التكوين والتقنيات من دون موهبة يعني ما ذهب إليه أندري جيد حين قال أن الفن يعيش بالإكراهات ويموت من الإفراط في الحرية.
ملاحظات حول مهرجان مراكش السينمائي الدولي
-مبارك حسني-
لا شك في أن مهرجان مراكش السينمائي الدولي يعد مكسباً فنياً مغربياً، له موعد بات منتظراً بل يخلق أفق انتظار، ليس بضخامة موارده ولا فخامة مقاره، بل لأنه ذو صبغة سينمائية بالأساس، وعصب وقائعه تشكلها نوعية الأفلام المختارة، والتي تكون في الغالب جديدة وإبداعية ومن بقاع فنية مكرسة ومعروفة في مجال الفن السابع، مع إطلالات محمودة تجاه سينمات في جغرافيا نائية ومجهولة. وأهم ما يميزه أنه حدث ثقافي فوق أرض سينمائية لها تاريخ فني محترم وتُنتج أفلاماً، وهو بالتالي ليس مستنبتاً في أرض قفر من الفن السينمائي، بخاصة في بلد من الجنوب.
مع سبتمبر2001
وقد صادفت دورة هذا المهرجان الأولى سنة وقوع هجمات (سبتمبر 2001 )، ما جعله يصير بقوة الحدث نافذة حداثة وعنوان تحد مُنخرط للفن السينمائي الجماهيري في أرض عربية وإسلامية، ضمنت الولايات المتحدة الأميركية حصة هامة في إشعاعه عبر الحضور المنتظم لرجالات السينما الأميركيين من مخرجين كبار وممثلين لامعين. ويضمن ذلك أكثر الأجندة العالمية للمديرة مليتا توسكان دي بلانتيي زوجة صاحب فكرة المهرجان الراحل المنتج دانييل توسكان دي بلانتيي والمدير الفني برونو بارد الذي يدير مهرجان الفيلم الأميركي بدوفيل الفرنسية. الأصل والبداية جعلا المهرجان فتحاً فنياً وثقافياً محمودان وافقا رغبة كبرى لدى المهتمين المغاربة في أن يعضد قدرات السينما المغربية بمخالطة ومقارعة تجارب سينمائية تاريخية ومرسخة، بخاصة أنها صادفت عهداً سياسياً بالبلد يتسم بالانفتاح والحداثة في أبرز مظاهرها الموافقة للتاريخ والأصالة المغربيين .
لكن كل هذا لم يمنع الكثيرين من انتقاده مراراً وإثارة العديد من الأسئلة حول فرنسية تنظيمه، لأن للمهرجان إدارة مزدوجة مغربية وفرنسية حتى أن بعض الصحافيين الغربيين نعتوه في البداية بمهرجان الفرنسيين قبل أن تؤكد الدورات خلاف ذلك، حين أكد فنيته وساهم في إشعاع مدينة مراكش كثيراً. ومع ذلك صار دورة بعد دورة يكرر نفسه، ولم يعد بالهالة القوية التي أبان عنها في دوراته الخمس الأولى، خاصة خاصية الاكتشاف والتجديد، ولم يضف مثلاً فقرات سينمائية تجعله يكبر في فنيته. صار مهرجاناً بلحظات معروفة وتسيير محايد وتعاقب أيام متشابهة. هو الذي كان منتظراً أن يخلق الحدث كل مرة وليس أن يكرره، على رغم أهميته. أفلام وفقرات وبذخ ملازم وأصداء إعلامية، لكن من دون محتوى ثقافي أكبر ومجدد. فأحد أفكار البداية أن يعقد المهرجان تحت مسمى يتناول قضية وعنوان مرحلة، ولا يكتفي فقط بعرض أشرطة وتقديم فرق هذه الشرطة تحت الأضواء. لا بد للثقافة أن تحضر أكثر ولا يتضاءل النقاش والجدال العمومي الكبير، فهل يستوي الاحتفاء من دون عمق ثقافي مرافق ومؤكد عليه؟ نعم، جميل استدعاء فلاسفة وأقلام من خارج البلد، لكن إذا لم يحضر كتاب البلد ونقاده ومثقفوه وأقلامه من مختلف الحساسيات والمشارب والأجناس الإبداعية، من خلال هيئاتهم وأعضائها، هل يؤدي اللقاء الثقافي مداه كله؟
السؤال المحلي
والسينما المغربية، هل استفادت من المهرجان؟ نعم من جهة المقارعة ربما، والحضور في الواجهة أمام لجنة تحكيم من عيار ثقيل عبر فيلم أو فيلمين في المسابقة وأفلام معينة في البانوراما الموازية، ولكن كيف يتم الاختيار إذا ما عرفنا أن جلها ليست له قدرة على المنافسة وبعضها يتسم بالضعف أو مغربي بالاسم فقط مثل فيلم الدورة الحالية «حمى» الناطق بالفرنسية والفرنسي الموضوع والطابع. على رغم وجود رغبة دفينة في أن يحصل فيلم مغربي ذات يوم عن النجمة الذهبية التي تقدمها لجان تحكيم تراهن على الجدة والأصالة والإبداع غير المسبوق. ولماذا لم تُخلق فقرة عربية أو أفريقية للسينما، ولا تُقرر فقرة للنقاد كما هو الحال في مهرجانات العالم الكبرى، ولماذا لم تنظم ندوات مفتوحة يستدعى لها الضيوف الكبار الحاضرون؟
هي بعض أسئلة تروم من مهرجان تخطى عتبة الدورة الثالثة عشرة، وتخطى مسارب البدايات، تروم أن يصير مهرجان الثقافة ذاك الذي أعلن عنه حين دشن أول لبناته قبل أكثر من عشر سنوات، وليس مهرجان الأضواء فقط، والزرابي المفروشة للمشاهير لا غير. فالفن السابع لا يقتصر عليها وإن كانت منه وبها يتألق. مهرجان مراكش ليس سوقاً للفيلم، بل لقاء ثقافة وفن لرجال ثقافة وفن من كل أنحاء المعمور لطرح قضايا الإنسان والعالم وقضايا اللحظة الحرجة الملحة، بين سكان جنوب الكرة الأرضية عامة والمغاربة خاصة وباقي العالم أولاً وأخيراً. إن حضور المخرج العبقري مارتن سكورسيزي رئيساً للجنة التحكيم للدورة الحالية بمواقفه الفنية والإنسانية المعروفة أبرز دليل على ضرورة الحفاظ على خط تحريري مميز، لكن هل التقاه المثقفون والفنانون المغاربة؟ وأين الصدى في المكتوب والمرئي والمسموع؟