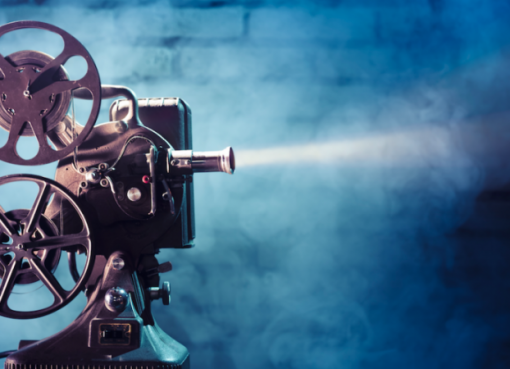في شريط «يما» للفنان المغربي رشيد الوالي، شيء من نزعة الحنين الطيبة، وقدر من السلاسة في الحكي اللطيف. يعني أن المشاهد يتناغم مع اﻷحداث ويساير مكنوناتها الموزعة كي تلقى هوى في نفسه. وهذا راجع باﻷساس لمسألة تأثير المخرج في أول عمل سينمائي مستقل له، والذي يؤدي فيه الدور الرئيسي كممثل، وبالتالي تتزاوج وتتداخل لديه المهمتان ما يجعل قراءة عمله مزدوجة أحياناً، من وراء الكاميرا وأمامها، كما يحدث تجاه مثل هذه الأعمال التي تكون في الغالب من إبداع مؤلفين سينمائيين. لكن هنا، المسألة تكتسي طابعاً آخر، فالمخرح يخرج من عباءة الممثل الذي يحتل المشهد كثيراً، بحيث تتوارى قبعة المخرج دون أن يغيب جسده وتَحَكُّمه العام في مجريات العمل.
حكاية بوجمعة
وهكذا يصير بوجمعة بطل الشريط هو ما يُشاهد أصلاً وتحديداً، إن لم نقل كلية. يؤدي رشيد الوالي في الفيلم دور رجل أربعيني اسمه إذاً بوجمعة. طيب ولطيف المعشر حد السذاجة التي تجعل اﻵخر المشاهد الذي يتتبع قصته يتماهى معه كل التماهي. بو جمعة هذا تتعطل لديه آلية العمل في مجال اﻹعلان، فيقرر تغييراً مهماً في حياته يتجلى في السفر، كما لو كان وصل أزمة منتصف العمر. لكن حالته في الحقيقة، أبسط من ذاك، فما يحركه هو تغيير جو لا يلبي ما يحتاجه ليبحث عن جغرافيا مغايرة يظنها أرحب وفسحة للحرية. يسافر إذاً، لكن ليس كما يُظَن إلى مدينة مغربية قريبة توافق شخصيته المرسومة المتأثرة رغماً عنها بالتقاليد العائلية الموروثة، ولكنه يرحل إلى جزيرة كورسيكا. تلك الجزيرة البعيدة عن التوظيف السينمائي المغربي، والذي يبدو أن رشيد الوالي تخيرها كي تكون له فتحاً إخراجياً، وفعلاً كانت، اﻷمر الذي يضيف إلى عمله الفيلمي نسائم وثائقية بمسحة جمال طبيعي ينافح ما هو عاطفي رومانسي. وهذا المعطى الأخير هو الطاغي والمحرك، فوجود بوجمعة في الجزيرة أملاه هدف شخصي هو لقاء حبيبة أوروبية علاقته بها لم تكن تتجاوز المعرفة الافتراضية.
وهو ما يعطينا فيلم سفر road movie، أي فيلماً يتأسس على هذه الفكرة اﻷصيلة سينمائياً، لكنّ الفكرة، رغم جاذبيتها لا تعدو أن تكون ذريعة، أولاً لتمكين الممثل من تبيان قدراته في معانقة وقائع تعترضه بما تحمل له من لقاءات مختلفة ومتعددة بأشخاص مختلفين ومتعددين أيضاً، لكل منهم حكاية وقصة يختلط فيها اﻷمل السعيد باﻹحباط ومعاكسة الظروف، بخاصة الشخصيات النسائية. وذريعة ثانياً لإبراز شخصية تتنامى الصورة عنها باختراع حاﻻت الصد والقبول، والرفض والتفهم، والاقتراب والتجاهل، الذي تتعرض له. بخاصة أنها حاملة ثقافة مغربية تتضمن الكثير مما ﻻ يوافق المجتمع الغربي حيث تود أن تجد لها موقعاً عصبه قصة الحب المأمولة. مثلاً صورته وهو يتأبط آلة كاتبة في شارع عام، وهو يلقي نظراته الحائرة أو المندهشة، وهو يبوح بعواطفه بكل طلاقة. علاقته المتوترة بوالده الذي يصفعه بعد أن انتقده لزواجه بفتاة صغيرة السن، حواره مع أخته حول زواجها المُعَد بكهل، صمت اﻷم الحزين (في مغازلة طيبة للعين الغربية الحساسة تجاه كل عنف تعرفه المرأة العربية). وأخيراً كشفه الوهم الكبير الذي كان يعانقه، والذي اصطدم بالواقع الناطق بالحقائق المُرة. فالمرأة المرجوة ليست تلك المرسومة في المخيلة المهيجة بالصور والاستيهامات. هي امرأة تعيش المشاكل ذاتها والقلق نفسه، ولم تجد وسيلة للتنفيس غير السفر عبر الوهم الذي يسطره الانترنت وعلاقاته الزئبقية الزبدية.
هي مواقف تنتقل، في أصل العمل، ما بين تصورين ونظرتين للمجتمع والحياة، عمادها ثيمة المعاصرة واﻷصالة التي تم التطرق إليها بما تقدمه من هذه المفارقات المطلوبة سينمائياً. ما يُرى هو تسلسل لحلقات متتالية ضمنها المخرج رهافة أحاسيس وتصادم عواطف، وصوراً صقيلة ناقلة محمولها دون اجتهاد خاص، وﻻ تحسين جمالي مقصود، إلا ما يمكن إيراده من تكرار للمحات والنظرات الجانبية، كما لاعتماد حوارات جبهية ﻻ تروم المواجهة سوى بالكلام، وليس بتضاد البورتريات الملتقطة الموازية لكل حالة شعورية.
مياه الضلال
إننا إزاء شريط يحكي قصته بأقل قدر من التوظيف للمعجم السينمائي، وبما هو أساسي يمكن من إيصال المراد، وهو تتبع مصير حلم بوجمعة في الجزيرة التي ستصير مرادفاً لانزواء هذا الحلم ومحاصرته بمياه من الضلال والغي. وهنا ينجلي صواب قدرة الممثل رشيد الوالي كمخرج. يلعب دوره كشخصية وعينه على كاميرا ﻻ تجاوز دورها الراصد المتقفي مع الحد اﻷدنى المماثلة المشهدية. السينما تقنية محضة لحكاية طيبة من تلك التي تمتع بسرد خطي مشابه للمعيش، ولا تُوَتر بأسئلة كبيرة ﻻ يدعي التطرق إليها رغم اﻹشارات التي يلمح لها، أسئلة تجملها العلاقة ما بين الغرب و «الشرق» حضارياً باﻷساس. رشيد الوالي يوظف ما راكمه في ميدان التشخيص ومجال الفن، وﻻ يبتعد عنه، وفاء منه لنفسه. هي سينما تقع في الوسط. ﻻ مدعية وﻻ متعالية.
هي سينما ممثل مخرج ابتدع شخصية سينمائية سبق أن ابتدعها وأداها باقتدار في أعمال تلفزية محترمة. وها هو في باكورته السينمائية هاته يرسمها. وكأني به يروم إدامة حضورها، لكنه لم يبتدع أفلاماً بعدها، وهو ما سيكون أمراً طيباً. خاصة وأن له هنا خاصية المبدع المسكون الذي يكفيه أن يصور الأسئلة هذه المرة.
مبارك حسني